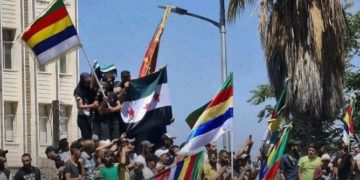رانيا مصطفى
يتصرّف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كقيصر طموح إلى استعادة نفوذ إمبراطوريّته السوفييتية الغابرة، وذلك عبر جعل التدخل العسكري في سورية بوابةً إلى التوسع الجيوسياسي في الإقليم. وعلى الرغم من أنّ روسيا لا تملك مقومات الدول العظمى الراهنة، إذ إنّ اقتصادها ريعي يعتمد على تصدير النفط، فهي تستغلّ تراجع الاهتمام الأميركي في المنطقة إلى المرتبة الثانية، وتراخي علاقات واشنطن مع حلفائها، في الخليج العربي، وتركيا، وحتى العراق.
لماذا تضع روسيا كلّ رهاناتها في سورية على استمرار نظام الأسد، مع وجود بدائل سورية عديدة مطروحة، وتدور في الفلك الروسي، ولا تعمل بجدّية على حل عقدة الوجود الإيراني في سورية، وإرضاء الأميركيين وأوروبا وإسرائيل والعرب، ورفع التعطيل الأميركي عبر قانون قيصر عن هدفها المركّب بعودة اللاجئين وإعادة الإعمار؟
تعتقد روسيا أنّ بمقدورها مواجهة واشنطن وحلفها الغربي، وأن تفرض نفسها مسيطرة على المنطقة برمتها، عبر بناء التحالفات الإقليمية، وفتح المسارات المتعدّدة، والمتعارضة أحياناً؛ كتحالف أستانة مع تركيا وإيران ويتعلق باتفاقات مناطق النفوذ، ومنصة الدوحة مع تركيا وقطر، وتدفع باتجاه قمة بغداد العربية بين العراق ومصر والأردن، والتي تقدّم مبادرة للحلّ في سورية، وموجهة ضد النفوذين، الإيراني والتركي، في سورية. وجسّ نبض دول عربية عن إعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية، هذا فضلاً عن التحالف العربي – الإسرائيلي الذي يستهدف التوسع الإيراني في المنطقة، وإطلاق مسار التطبيع.
جاء الحراك الروسي، أخيراً، بعد اتّضاح ملامح سياسة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن؛ إذ يبقى همّ تعزيز القواعد العسكرية في بحر الصين، ضمن الأولويات الأميركية، وعلى حساب تقليص حجم الوجود العسكري في الشرق الأوسط، والاعتماد أكثر على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في استكمالٍ لسياسة كلّ من أوباما وترامب، من دون أن تتغير الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، حيث تمسك واشنطن بكلّ خيوط التحالفات فيها، وتتمتع بقدرتها على تعطيل المسارات، حين لا تتوافق مع مصالحها؛ وكذلك تستمر الإدارة الأميركية في تطبيق سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، مع استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقعها في سورية، كما كان في عهد ترامب، وذلك قبل الخوض في مفاوضاتٍ حول اتفاق نووي جديد مع طهران.
تشهد العلاقات الأميركية – الروسية تراجعاً في عهد بايدن، مقارنةً بما كان في عهد ترامب، وبالمثل، هي العلاقات التركية الأميركية. ولا تبدي الإدارة الأميركية الجديدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، غير التشدّد في تعطيل المساعي الروسية إلى تعويم نظام الأسد، والقفز فوق الحلّ السياسي، وباتجاه عودة العلاقات العربية مع دمشق، عدا عن موقف غربي عام يدين جرائم النظام. وبالتالي، يدفع هذا روسيا إلى حراك دبلوماسي في المنطقة، باتجاه بناء تحالفاتٍ فيها، في غياب تنسيق عربي، وذلك من أجل أن تمسّك روسيا بكلّ الخيوط التي تحقق التوازن بين دول المنطقة المتنافسة على النفوذ، وأن تلعب دور الوسيط بينها. وروسيا تستفيد هنا من توجّه الصين إلى تقوية علاقاتها مع دول المنطقة، خصوصاً الاتفاق الاستراتيجي الإيراني – الصيني، وعلاقات أكثر قوة مع دول الخليج، بالتوازي مع عقود اقتصادية قصيرة الأمد بين روسيا وإيران، وعلاقات لروسيا أقوى مع الخليج ومصر والعراق، ومحاولتها أخذ دور في اليمن، عبر دعم الحوثيين بالتحالف مع إيران، فضلاً عن نفوذها في حوض المتوسط، ودورها في الصراع الليبي، بالتحالف مع الإمارات والسعودية ومصر.
هذا الطموح الروسي لنفوذ أكبر في المشرق العربي وعموم غرب آسيا، دفع روسيا إلى معاندة أميركا في المنطقة، واعتبارها ندّاً لها، بدلاً من التواضع، والاعتراف بمحدودية القدرة الروسية، في مقابل الهيمنة العسكرية والاقتصادية الأميركية على العالم. وبالتالي، تتجاهل روسيا التي تبحث عن نفوذ وهيمنة على المنطقة، حقيقة عجزها عن الهيمنة على سورية، عبر دعم نظام الأسد، وإخضاع تركيا والمعارضة التي تدور في كنفها إلى اتفاقات أستانة والمصالحات، وعبر توقيع عقود استثمار طويلة الأمد لأهم الموارد الحيوية وللمطارات والطرقات؛ هي عاجزة بحكم الوجود الأميركي شرق الفرات، وفي قاعدة التنف شرقاً، ودعم واشنطن قوات سورية الديمقراطية (قسد) وإدارة ذاتية للمنطقة، والسيطرة على غالبية حقول النفط والثروات الطبيعية والحبوب، ومنعها عن النظام وروسيا، وفاعلية قانون قيصر في منع أيّ حلول روسية منفردة، تتعلق بتعويم النظام من دون تحقيق الشروط الأميركية. إذاً، ليس في مقدور روسيا تغيير هذه الحقيقة بالقوة العسكرية، بل بتوافق دولي، عليها تقديم تنازلات فيه، ومنها إخراج إيران من سورية، والبدء بالحلّ السياسي وفق القرارات الدولية.
هناك علاقات تاريخية قوية بين دول الخليج العربي والغرب الأوروبي وأميركا، ووجود عسكري أميركي بقواعد ضخمة في مفاصل مهمّة تجعل حكومات تلك الدول عاجزة عن التحليق بعيداً خارج السرب الأميركي، باتجاهات فضاءات روسية أو صينية غير مضمونة. وكذلك بالنسبة لتركيا، فإنّها على الرغم من مضيّها في صفقة المنظومة الدفاعية الروسية “إس – 400” وعلى الرغم من جفاء إدارة بايدن لها، فإنّها لا تثق بروسيا بسبب سياساتها الانتهازية في استغلالها المخاوف التركية من خطر التوجهات الانفصالية الكردية شمالي سورية، وكانت ستفضل الحليف الأميركي لولا ذلك.
تفضّل روسيا إبقاء إيران في حلفها، ضدّ رغبة الولايات المتحدة في احتوائها، وهي لا ترغب في مواجهةٍ مع طهران داخل سورية، على الرغم من المنافسة بينهما على الاستثمارات، وفي السيطرة على مفاصل القرار السوري، وهي لا تملك وسائل تحدّ من قوة (وتوسع) إيران وأدواتها على الأراضي السورية، كالحرس الثوري وحزب الله اللبناني، غير السماح للطائرات الإسرائيلية بقصف القواعد العسكرية الإيرانية ومخازن أسلحتها، فالحدّ من النفوذ الإيراني في سورية يحتاج إلى توافق دولي، ولا يبدو أنّ هذه الخطوة ضمن أولويات الغرب، خصوصاً مع تعثر انطلاق مفاوضات فيينا المبدئية مع إيران بشأن برنامجها النووي.
الولايات المتحدة الأميركية راضية، ومشاركة عن بُعد في كلّ خطوات موسكو على الأراضي السورية، من تعزيز قواعدها في الساحل السوري، ومسار أستانة، واتفاقات خفض التصعيد والمصالحة، ومسار اللجنة الدستورية، وملف الجنوب وغيرها، ودعمت تركيا لتعطيل تقدم النظام إلى عمق إدلب. لكنّ واشنطن، أيضاً، سعيدة بحالة الاستنقاع السوري التي تستهلك الروس والإيرانيين والأتراك معاً، وتُضعف سورية دولةً وحكومة، أي لا تتوفر إرادة دولية للحلّ في سورية في الفترة القريبة، وهذا يعني استمرار حالة الاستنقاع، مع استمرار واشنطن في وضع العراقيل في وجه أي تحرّك روسي لفرض حلّ منفرد.
وبخلاصة مكثّفة، كلّ التحركات الدبلوماسية الروسية لبناء تحالفات وتكتلات في المنطقة خطوة فارغة من القيمة الفعلية، ولن يكون لها أثر سوى أنّها ستشكل، في حال نجاحها، بعض الأوراق في يد موسكو، قد تستفيد منها لحظة التفاوض مع واشنطن.
المصدر: العربي الجديد