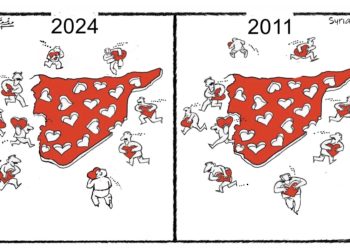لعل مخاض الثورة السورية كان ومازال عسيرًا، وبداياتها السلمية التي دفعها (النظام الأسدي) إلى مستنقع العسكرة، ومعه ومن خلاله الشد القسري نحو الطائفية، التي لم تكن بالأساس منهجًا ولا طريقًا سالكًا أمام قوى الثورة السورية، بكل ألوان الطيف الذي تشكلت منه، كان همها الرئيس الحرية والكرامة المفقودتين في زمن الأسد، زمن التغول الواضح للدولة الأمنية، على مدى حكم وهيمنة سلطة الأسد الأب ومن ثم الابن، الذين كرسا (وبشكل واضح) دولة العصابة، الدولة الأمنية المنفلتة من أي عقال موضوعي يمكن أن يكون ناظمًا أو محددًا لها، خلا عمليات التعدي على كل ما في الوطن ونهب موارده وسلب ثرواته، وإلغاء أي صوت معارض فيه، وسحق أي محاولة للثورة أو العصيان، مهما كانت صغيرة، أو غير ذات جدوى، حتى باتت السياسة كابوسًا يخيف كل متلفظ لها أو متعاط لآلياتها، فامتلأت السجون بأصحاب الرأي المعارض، وتمت تصفية كل الذين يفكرون بأي لمحة تفكير للانقلاب على السلطة الفاجرة في دمشق.
انطلقت ثورة الشعب السوري سلمية بامتياز، فحولها نظام الأسد قسرًا إلى السلاح دفاعًا عن النفس، وعن العرض، وعما تبقى من إمكانية للانتفاض، فبدأت (كما نعلم جميعًا) بانشقاقات أدت إلى تشكيل الجيش السوري الحر، لكنها ومع التدخلات الخارجية تحولت الى تشكيلات عديدة ، وذات منابع ومناهل خارجية في معظم حالاتها، بحيث انفرط عقد الجيش الحر، ليصبح جيوشًا متنوعة متعددة، متناثرة، ناهيك عن التفرقة وعدم التمكن من الإمساك بقيادة عسكرية منسجمة، تتمكن من التصدي لهذا النفير الطائفي الخارجي، الذي استقدمته ايران للامساك بتلابيب سورية، وباسم الانتصار للحسين، وتنفيذًا لمشروعها الفارسي الطائفي، ولتتكوم جميعًا حول حلب، ثم الغوطة الشرقية وعاصمتها دوما، لأنهم وجدوا فيهما تلك المعركة الفاصلة التي لابد من الانتصار فيها، على مجمل كتائب وثوار سورية. وجاءت معهم روسيا لتلتقي مصالحها مع مصالح إيران، لكن ضمن سياقات أخرى، وأهداف مختلفة.
الثوار في حلب والغوطة الشرقية أيضًا، ظنوا أن الحرب النظامية التقليدية يمكن أن تنتصر على تلك الجحافل الحاقدة الآتية مع جيش النظام، أو ما تبقى منه، ولم يأبهوا البتة الى أن حرب التحرير الشعبية / حرب العصابات هي الأقرب لإمكانية تحقيق أي انتصار على جيوش نظامية، يدعمها الطيران وكل أسلحة روسيا الحديثة والمتطورة.
مع ذلك وبعد كل ما جرى يبدو أنه لابد من العودة الى الوراء قليلًا ودراسة الامكانية والآلية العسكرية الجديدة الأفضل، لخوض معركة متواصلة، وهنا تصعد للذاكرة مرة أخرى مسألة حرب العصابات التي عملت عليها في السابق ثورات كثيرة وأدت إلى انتصارها على دول كبرى وعظمى، ونذكّر هنا ما فعلته في الجزائر في مواجهة الفرنسيين، وأيضًا الثورة الفيتنامية ضد الأميركان، وقبلهم الفرنسيين، وفي بنغلاديش وفي الصين ضد اليابانيين. حرب العصابات لا تشبه الحرب التقليدية، وتفترق كليًا في مجمل مبادئها وقوانينها، وكذلك ماهية الإعداد لها. فهي تتكئ على العديد من المحددات والعناصر منها البعد الاستراتيجي المتعلق بكل عملياتها، وأيضًا التكتيك المرتبط بأساليب التنفيذ لهذه العمليات والمعارك، ومن ثم التقانة العلمية التي تساهم في حسم الكثير من مواقفها، وفي النهاية التخطيط والخطة والتي تساهم في عملية تمفصل تلك العناصر الثلاثة ضمن سياق الزمان والمكان.
يقول الاستراتيجي العسكري (صن تزو) “في حرب العصابات لا تحتل أرضًا، اقتل عدوك واهرب، داهم عدوك من حيث لا يتوقع، وكن مثل بقعة الزيت إذا ضاق عليك المكان انتقل الى غيره” فهل يمكن أن نتعلم من هذه الرؤية الاستراتيجية، لحرب العصابات أو حرب التحرير الشعبية؟
إن إعادة قراءة التاريخ، تاريخ الشعوب تعتبر منطلقًا لابد منه، تجارب الشعوب البعيدة، وتجارب العرب والمسلمين القريبة، ففي تجاربنا ما يمكن أن نتعلم منه أيضًا، وفي هزائمنا الكبيرة في العصر الحديث، ما يمكن اعتباره دروسًا لا يمكن القفز من فوقها أو تجاوزها. أخطاء الشعوب دروس مستفادة، هكذا لابد من أن تكون.
يقول ياسين الحافظ بعد هزيمة عام 1967في كتابه (الهزيمة والايديولوجيا المهزومة) ” نحن العرب لم نفقه بعد وحدة الزمان، أي ترابط وتواصل وحداته أو لحظاته، كما أننا لم نفقه بعد أن هذا الترابط ذو طابع سببي وتراكمي. لذلك نخدع أنفسنا بالحديث عن (لحظات تاريخية) و(أيام مصيرية) … فلسطين لم تسقط في أيام، كما لم تسقط في شهور، بل إنها كانت تسقط كل يوم كسرة بعد كسرة، وحجرًا بعد حجر”. فهل نتعلم من كل هذا السقوط المدوي في حلب ثم الغوطة الشرقية ودوما، وقبل ذلك وبعده في حمص وريف حمص وداريا، وخان الشح، ومخيم اليرموك، وكل ألاماكن التي خسر فيها الشعب أمام الطغاة من نظام سوري، أو روس، أو إيرانيين، أو ميليشيات طائفية قذرة، استقدمت من كل بقاع الدنيا .