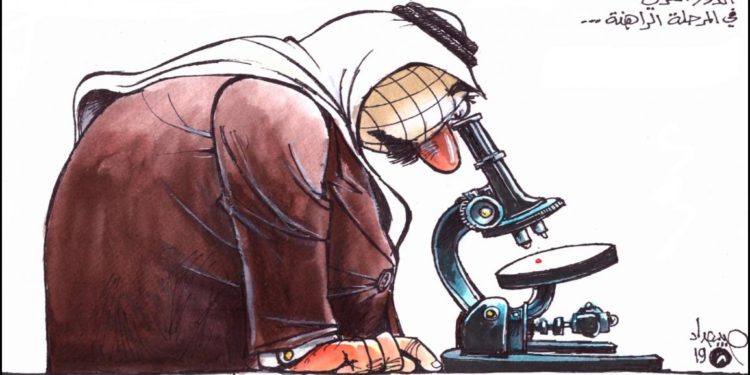أسامة أبو ارشيد
مآسينا أو مخازينا، وكلاهما، للأسف، صحيحان في حالنا نحن العرب، أكثر من أن تعدّ أو أن تُحصى. أينما ولّيت وجهكَ تفجع بالواقع الآسن والكئيب الذي عليه أمّتنا. تتساوى هنا، إلى حدّ كبير، الأنظمة والشعوب. وحتّى لا نستطرد في سرد الجراح، نكتفي بواحدٍ هو أشدّها نزفاً اليوم في جسدنا، وفي الوقت ذاته، أكثرها تجّسيداً لأملنا في مستقبل أفضل. تُعربد إسرائيل في قطاع غزّة، تُدمّره، وتُبيد ناسه، ويموت أطفاله جوعاً، وتُبتر أعضاء مصابيه من دون مخدّر، ولا معدّاتٍ طبيةٍ، بسكين مطبخ على طاولة طعام، ليس لهم من عزاء ومخفّف للألم الرهيب إلا آيات من الذكر الحكيم يتلونها، ومع ذلك، لا تتحرّك نخوة أنظمة، بعضها شريك متورّط في حصار غزّة وأهلها، وأخرى ساعية للتطبيع معها (إسرائيل)، وثالثة تمدّها بالطعام والبضائع. الأدهى، ألا تُسْتَفَزَّ شهامة غالبية شعوب العرب، المغلوبة هي الأخرى على أمرها. تُرى، كيف ستحاكم الأجيال القادمة هذه الحقبة التاريخية، التي هي راهننا؟ بل كيف ستنظر إلينا؟ لن يكون هناك مجال للتشكيك في الحيثيات، فهي موثّقة صوتاً وصورة. ولا أدري إن كان من اللائق التساؤل: تراها ستكون هناك أجيال عربية قادمة أحسن من جيلنا حتّى تنظر إلى هذه المرحلة السوداء في تاريخنا الجمعيِّ بعار وجلل؟… أتمنّى ذلك. لكنّ مستقبلاً أزهى لا يُصنع بالتمنّي، وإنّما برؤية نهضوية شاملة، عميقة وجامعة، وبتخطيط استراتيجي واعٍ ومُحكم، وبعملٍ متقنٍ رصين، وقبل ذلك، بطليعة فكرية وتنظيمية، متجاوزة لحساسيات الانتماءات القبلية والقُطْرِيَّةِ والأيديولوجية والسياسية، ولديها القابلية والقدرة على تقديم التضحيات الجِسام.
حتّى نجيب عن سؤال: “أليس الصبح بقريب؟”، لا بدّ لنا، أولاً، أن نُحدّد أيّ صبح نُريد؟ أعلم أنّ هذا سؤال شائك، حتّى لدى النخب الساعية للتغيير، إذ تتنازعه التحيّزات الأيديولوجية والتفصيلات الفرعية. لكن، على الأقل، بعض خطوطه العامة معلومة. نُريد صبحاً تكون فيه بلادنا أوطاناً لشعوبها لا سجوناً لها. نُريد عقدَ مواطنة وحقوق، لا تبعية وخنوع. نُريد حرّية وكرامة وديمقراطية حقيقية، لا مكان فيها لقمع ولا لفساد مُحصّن. نُريد شكلاً من أشكال الوحدة العربية، تُضعِف، إن لم تُلغِ، العقلية القبلية والقُطْرِيَّةِ المقيتة. نُريد مشاريع اقتصادية وإنمائية حقيقية متكاملة. نُريد قوّة تُرغِمُ الآخرين على احترامنا. إذا كان في راهننا من شاهد فهو أنّ العالم غابة متوحّشة، مهما زعم سادته وجود مؤسّسات ومعاهدات واتفاقيات وإعلانات تؤكّد حضاريته. في هذا العالم القوّي وحده هو من يستحق الحياة مرفّهاً ومنعّماً وفوق كلّ قانون وأيّ محاسبة. خطاب “المعايير المزدوجة” هو بكائية الضعفاء، أمّا الأقوياء فإنّهم يمارسونها، في الوقت ذاته الذي يَدَّعونَ فيه تفوقاً أخلاقياً، واستثنائية إنسانية. أليس هذا ما تفعله الولايات المتّحدة؟ أليس هذا ما تمارسه إسرائيل؟ تُدَمَّرُ غزّة عن بكرة أبيها، يُقتل أطفالها ونساؤها وعجائزها ورجالها بالسلاح الأميركي، على أيدي جنود إسرائيليين متوحّشين عديمي الأخلاق، ومع ذلك يقولون إنّ لإسرائيل “الحقّ في الدفاع عن نفسها”. أما الشعب الفلسطيني، فليس له إلا أن يقبل الإبادة والإخضاع ونزع إنسانيته. إنّه قانون القويّ في عالم، كان، ولا يزال، وسيبقى، متوحّشاً، ولا يكسر بعض حدّته إلا امتلاك أسباب القوّة المُضادّة.
كثير من أنظمة العرب تظنّ أنّ خلاصها وبقاءها يكون عبر سحق شعوبها وكسر كرامتها، في الوقت ذاته الذي تنحني فيه ذلّاً وتبعية أمام أطراف خارجية أجنبية. ترى هل أفلحت هذه المقاربة؟ هل رفعت من قدر أصحابها وشأنهم؟ هل تطوّرت بلادهم؟ بل هل حمتهم؟ هم يرهنون مصائرهم بيد من يدعمهم ما داموا أقوياء، أما حين تزلّ قدم أحدهم يكونون كالسكين على رقبته، وما زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، وعلي عبد الله صالح، إلا حلقات غابرة في سلسلة طويلة من البيادق القابلة للاستبدال. إنّ ما يجري مُخزٍ حقّاً؛ أنظمة تُفضّل أن تبقى تابعة خانعة مفعولاً بها، على أن تعيد النظر في مسارها، وتسعى في طريق إنجاز استقلال حقيقي، ودول قوية بمواطنيها، وبناء منظومة عربية متماسكة قادرة على فرض هيبتها واحترامها على العدوّ قبل الصديق. الشعوب العربية، أيضاً، رضيت، في جُلّها، حياة المهانة واستمرأتها، بل إنّ فيها من يبررها، ويعدّها أمراً طبيعياً جينياً في صلب هويتها وإنسانيتها. ومن ثمَّ، ترى تلك الشعوب تتخطف واحدة تلو أخرى، في العراق، في سورية، في اليمن، في السودان، في ليبيا… وإذا بقي الحال من دون تغيير فإنّ الدور سيصل إلى الجميع.
لكن، الانكسار والاستكانة والرضوخ والتبعية ليست بالضرورة قدَراً علينا إلا إذا قبلنا بها واستسلمنا لها. رغم فاجعة ما يجري في غزّة إلا أنّ الروح التي بثّتها في هذه الأمة تمثّل فرصة لها للنهوض ونفض غبار المهانة عنها. تعلمنا غزّة أنّ الكف قادرة على كسر المِخرَز إن كانت هناك إرادة حياة حرّة وكريمة، وإن كانت هناك إرادة تضحية في سبيل ذلك، وإن كانت هناك إرادة تحدٍ وصمود. فشلنا، أنظمةً وشعوباً، في اغتنام بارقة الأمل هذه، فإن استمر هذا الحال، فإنّ صباحنا سيكون فاجعة وكارثة، نساق فيه، فرادى وزرافات، كالغنم إلى المسالخ. أمّا إن نجحنا في توظيف هذا المفصل التاريخي نقطةَ تحولٍ في سيرورتنا، سواء كنا شعوباً أو أنظمةً، أو شعوباً وحدها، فحينها يمكن أن نتخيّل صُبحاً مُشرقاً مُزهراً، فنخرج من هذا الكابوس المُرعب الذي نعيشه.
المصدر: العربي الجديد