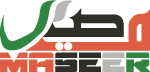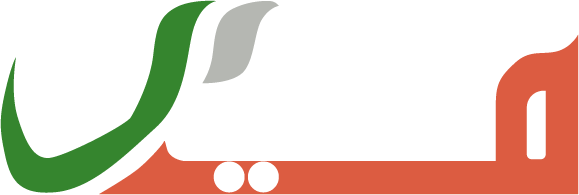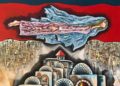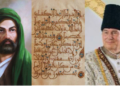سمر يزبك
إذا كانت السرديات الكلاسيكية لتاريخ النكبة الفلسطينية استطاعت أن تفرض تسلسلاً خطّياً للأحداث، فيكون التهجير الفلسطيني عام 1948 بدايةً، ومن ثمّ التهجير والمنفى استمراراً، فإن صورة الغزّيين المحتشدين على جسر وادي غزّة استطاعت أن تربك هذا “النصّ التاريخي” برمّته. سيلٌ بشريٌ يتدفّق في طريق العودة إلى شمال القطاع، تتقاطع الأزمنة هنا حقيقةً لا مجازاً، تتفكّك الحدود بين الدمار والعمران، بين الغياب والحضور، بين الوطن والمنفى. تحليل الصور البصرية هنا يعجز عن الوصول إلى معنىً واحد، بل يكشف تداخل الطبقات الزمنية والرمزية، التي تجعل هذه الصورة أكثر من مُجرَّد توثيق لحظة، بل نصّاً مفتوحاً على قراءاتٍ متعدّدة، إذ تمتزج الأبعاد التاريخية بالحاضر، ويصبح الحدث فردياً وجماعياً في آنٍ واحد. فالعودة هنا ليست مُجرَّد رجوع إلى مكان، بل إعادة إنتاج مستمرّة لفعل البقاء والمقاومة. إنهم لا يعودون إلى منازل قائمة، بل إلى أنقاض، يُعيدون بناء علاقتهم بالمكان، ويفرضون وجودهم ضدّ محاولات نقل المكان من مكانه. هنا يكون مُجرَّد الجلوس على جدار مهدّم نوعا من اتخاذ موقف تاريخي، حيث لا يكون الانتظار سكوناً، بل تحفّزاً لاستعادة ما فُقِد. في هذه اللحظة، لا يبدو الفلسطيني ضحيةً سلبيةً للنكبات فقط، بل فاعلاً يحاول إعادة تشكيل الجغرافيا وفق إرادته.
لم يترك الفلسطيني أرضه، بل أُرغم على الخروج منها، لكنّه حملها معه أثراً في الجسد والهُويَّة
تبدو الصورة تنتمي إلى أرشيف بصري متكرّر في التاريخ الفلسطيني. المشاهد تتكرّر منذ نكبة 1948، إلى الاجتياحات المتكرّرة، إلى الحروب المتتالية، وكأنّ الفلسطيني محكوم عليه بالتحرّك داخل الدائرة المغلقة نفسها من التهجير والعودة. لكن ما يجعل هذا المشهد مختلفاً هو أنه (رغم التشابه)، يحمل دلالات جديدة، إنه ليس مُجرَّد إعادة إنتاج للمأساة، بل فعل استمراري يعيد تعريف العلاقة مع الأرض. هنا لا تصبح العودة استعادة للمكان فقط، بل تحدّياً للتاريخ، الذي يحاول طمس معالم الهُويَّة الفلسطينية. لقد صُوّرت عودة الفلسطينيين فعلاً سياسياً يتحقّق عبر قرارات دولية فقط، لكنّ عودة الغزّيين اليوم تبدو فعلاً مستمرّاً، ليس عبر السياسات، بل عبر الجسد ذاته. هؤلاء العائدون يحملون أجسادهم أدلّةً مادّيةً على حقّهم، ويحوِّلهم أفراداً فاعلين في تشكيل حيّزهم المكاني، ويعيدون تشكيل المكان بحضورهم، وليس بالبنيان فقط. يعودون محمّلين بالذكريات عن الحروب المتكرّرة على بيوتهم، ورغم أنّ الحرب الآن قد تطابقت مع فعل الإبادة، لكن يبقى التذكّر فعلاً تأسيسياً يُرسِّخ العلاقة مع المكان رُغم محاولات المحو.
الفلسطينيون (في عودتهم هنا) يتحدّون مركزية التأطير الكلاسيكي، التي اعتاد التصوير الفوتوغرافي للتاريخ توثيقها. فبدلاً من نقطة تركيز واحدة، نجد امتداداً بصرياً بلا حدود، فيصبح كلّ فرد جزءاً من الكلّ، لكنّه في الوقت ذاته كيان مستقل. لا يوجد بطل واحد يهيمن على المشهد، بل كلّ شخص هنا يحمل قصّته الخاصّة، وتجتمع هذه القصص لتشكّل روايةً غير مكتملة، مفتوحةً، دائمة التغيّر. التركيب البصري لهذه الصورة يمنحها ديناميكيةً خاصّةً، فتبدو الحركة ممتدّة، والزمن متداخلا، وكأنها ليست مُجرَّد لحظة، بل سلسلة من اللحظات المستمرّة، التي تتوالى بلا انقطاع. “الاستعارة البصرية” هنا لا تروي حدثاً معيناً (عودة الفلسطينيين إلى غزّة بعد القصف) فقط، بل تستحضر تاريخ العودة الفلسطيني كلّه، وتستدعي صوراً أخرى من الأرشيف الجماعي، ممّا يجعلها تخرج من زمنها المحدود، لتصبح جزءاً من الزمن الفلسطيني ككل. يمكننا أن نرى في الوجوه المرهقة والمُصمِّمة إرث النكبة، يمكننا أن نستشعر صدى المشاهد القديمة في كلّ خطوة تخطوها هذه الحشود، وكأن الفلسطيني، عبر جسده، يكتب سرديته الخاصّةَ خارج أيّ هيمنة خطابية. وإذا كان الاحتلال يُمارَس عبر السيطرة على الأرض، فإن الفلسطيني يردّ عبر السيطرة على الجسد. هذه الصورة تكشف كيف يصبح الجسدُ ذاته أداةَ مقاومةٍ: آلاف الأجساد التي تتحرّك في مشهد أشبه بـ”الطوفان البشري”، تعيد تشكيل الخريطة الجغرافية والسياسية عبر الفعل الفيزيائي للحركة. تتحوّل المسيرة من مُجرَّد حركة جسدية إلى فعل وجودي، يواجه محاولات الإقصاء. إنها حركة تؤكّد أن الفلسطيني لا يُمحَى، بل يتجدّد في كلّ عودة، وأن وجوده ليس مُجرَّد حالة طارئة، بل فعل تأسيسي مُتجذِّر. الفضاء هنا ليس مُجرَّد امتداد جغرافي، بل هو مسرح لصراع دلالي بين الاحتلال وسكّان الأرض. وهكذا، فإن هذا المشهد ليس مُجرَّد عودة، بل إعادة امتلاك للمكان من خلال الحركة الجماعية. الطريق الذي يسيرون فيه ليس مُجرَّد طريق، بل هو أثر لخطواتهم المتكرّرة، هو استعادة رمزية لمسار التهجير، ولكن بعكس الاتجاه هذه المرّة.
الصورة هنا لا تُقرأ باعتبارها مُجرَّد “حقيقة موضوعية”، بل باعتبارها نصّاً محمّلاً بالتحيزات المختلفة. هل هي صورة توثيقية تُستخدم للدلالة على صمود الفلسطينيين؟ أم صورة يمكن استخدامها في سياقات إعلامية لتصويرهم مجموعةَ ضحايا من النازحين الدائمين؟… هنا، يُفكّك الخطاب البصري ذاته، فالصورة لا تنقل “حقيقةً” واحدةً، بل يمكن قراءتها بطرق متناقضة بناءً على السياق والسردية المستخدمة. كلّ زاوية نظر تعيد تشكيل معناها، وكلّ متلقٍ يضفي عليها تفسيراً خاصّاً، ما يجعلها مساحةً مفتوحة للنقاش والتأويل. الصورة أيضاً لم تقتصر على نقل الحدث، بل ساهمت في تشكيله. ليست مُجرَّد توثيق لعودة الفلسطينيين، بل هي في حدّ ذاتها جزءٌ من فعل العودة، لأنها تؤرشفها، وتمنحها بعداً بصرياً يعيد إنتاجها في الذاكرة الجماعية. توجد هناك إرادة كافية لذلك، لا تجعل من العودة، فعلاً جسدياً فقط، بل تحدّياً سياسياً وثقافياً ضدّ السرديات التي تحاول محو الفلسطيني من مشهده الطبيعي. في ذلك، تخلق الصورة خطاباً بصرياً مقاوماً، إذ تفرض حضور الفلسطيني على الرغم من محاولات إقصائه.
العودة ليست مُجرَّد عبور للحدود الجغرافية، بل هي استعادة مستمرّة للمكان في الذاكرة واللغة
في النهاية، هذه ليست مُجرَّد صورة للاجئين العائدين، بل هي صورة لمقاومة الجغرافيا والزمن، صورة تفكّك الخطاب السائد حول اللجوء، وتؤكّد أن العودة ليست لحظة واحدة، بل عملية مستمرّة، تتكرّر في كلّ جيل. “لا يوجد نصّ بريء”، هذا صحيح، كذلك لا توجد صورة محايدة. كلّ صورة تحمل بداخلها صراعاً على المعنى. قال المخرج جان لوك غودار، في فيلم “موسيقانا”، إنه “كما أن الإسرائيليين سيبقون محكومين باختراع الخيال كي يستمرّوا، لم يبقَ أمام الفلسطينيين في الوقت نفسه سوى التوثيق للتمسّك بالحقيقة”، وهذا المشهد تحديداً هو الإثبات الأكثر دقّةً لهذه الفكرة، ومن التجسيدات الأكثر وضوحاً لهذا الصراع البصري بين الاحتلال والمقاومة، بين الغياب والحضور، بين الماضي والمستقبل. وذلك بدوره يجعل من فكرة أن الفلسطينيين قد تخلّوا عن أرضهم متهافتةً أمام الواقع. إن هذا الادعاء يتجاهل حقيقة أن الفلسطيني لم يغادر طوعاً، بل أُجبِر على ذلك تحت وطأة العنف والتهجير القسري المعروض على الهواء مباشرة هذه المرّة.
إن العودة ليست مُجرَّد عبور للحدود الجغرافية، بل هي استعادة مستمرّة للمكان في الذاكرة واللغة. وهنا، يتجلّى مفهوم “الأثر”، فلا يكون الشيء حاضراً بالكامل ولا غائباً بالكامل، بل يترك أثره في كلّ شيء. الفلسطيني لم يترك أرضه، بل أُرغم على الخروج منها، لكنّه حملها معه علامةً لا تُمحى، أثراً في الجسد والهُويَّة. إنهم لا يعودون إلى الفراغ، بل يعودون إلى تاريخهم، يعودون ليؤكّدوا أن الأرض لم تكن يوماً مُجرَّد مساحة جغرافية، بل ذاكرة حيّة تستعصي على المحو.
المصدر: العربي الجديد