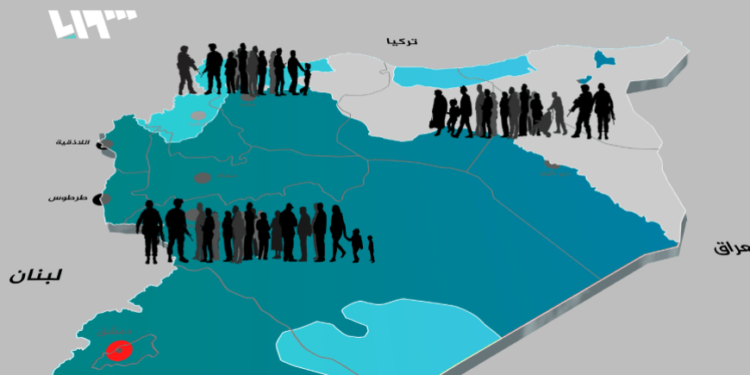حسن النيفي
في مسرحيته المشهورة (الفيل يا ملك الزمان) يحاول المرحوم سعد الله ونوس التأسيس لمفهوم (الاحتجاج) كسبيل للمطالبة بالحقوق والخروج عن نطاق الصمت والخنوع، وذلك من خلال التجرؤ على محاورة الحاكم، ولكن نهاية المسرحية تكشف عن خيبة وإحباط كبيرين نتيجة استبداد الخوف في الشخصية التي انتدبها القوم لمحاورة الملك، ولا يرى (زكريا) مخرجاً من ورطته سوى بإظهار التعاطف مع الفيل المسكين الذي يعاني من الوحدة، علّ الملك يجلب له فيلةً كي تؤنسه، وهكذا يتحول المسعى إلى التحرر إلى استمرار في العبودية.
يحضر فحوى المسرحية السابقة بقوة لدى قراءة مقالة نُسبت للكاتبين الأستاذين (زيدون الزعبي وعمر عبد العزيز الحلاج) ونُشرت في موقع (180 بتاريخ 20 – 6 – 2024)، والمقال المذكور إذ يشكو من نزوع شعبوي لشيطنة أو تخوين الأصوات التي تنادي بالمصالحة، وتدعو إلى الحوار كسبيل أمثل للحفاظ على الدولة السورية والحيلولة دون تقسيمها، إلّا أنه في الوقت ذاته يحاول أن يضع محدّدات وضوابط للحوار منها البحث عن مصير المفقودين والمغيّبين والمخطوفين، وعدم تأطير المصالحة أو الحوار بإطار زمني محدد (بل هي عملية مضنية وطويلة)، وكذلك أن يكون الحوار سورياً خالصاً، ثم شمولية الحوار للجميع دون إقصاء أيٍّ كان.
وللتأكيد على مشروعية المصالحة أو الحوار، يستشهد الكاتبان بالقرار الأممي (2254) الذي ينص بشكل صريح على مفهوم (التوافق) الذي يعني من الناحية الفعلية الحوار مع الآخرين بمن فيهم الخصوم.
كلام حق في سياق باطل
يمكن التأكيد على أن المقال المذكور لو وقع بين يدي قارئ محايد (أي ليس سورياً، وليس لديه أي إحاطة بالحالة السورية) لوجد فيه كلاماً طيباً وباعثاً على الاطمئنان. وكذلك لو قرأ المقال أيّ مواطن سوري في الأيام أو الأشهر الأولى لانطلاقة الثورة السورية، لوجد فيه أيضاً ما تستجيب له معظم تطلعات السوريين الذين – بالتأكيد – لم يكن لديهم ذلك النزوع الشديد إلى الحروب والاكتواء بحريقها وتجرّع مآسيها، ولكن أنْ يُكتبَ هذا المقال بعد ثلاث عشرة سنة من الحرب ووصول البلاد السورية إلى مآلات موغلة في الفجيعة، ويبقى أصل المشكلة غائباً أو مُغيّباً، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، وكأن السوريين جميعاً كانوا في غمرة من الجنون وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم لاستدراك ما فاتهم، فتلك هي المشكلة حقاً، بل ربما تبدو المشكلة أكثر تعقيداً حين نعلم أن كاتبيْ المقال هما ربما من أكثر الناس متابعةً للشأن السوري ولسيرورة الحدث السوري منذ عام 2011 ، وذلك بحكم عملهما في منظمات المجتمع المدني ومساهمتهما المستمرة في إدارة ورش العمل وتسيير جلسات الحوار، والإشراف على ندوات ومؤتمرات ذات صلة بالشأن السوري في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أتاح لهما حيازة كمٍّ كبير من الخبرة والوفرة المعرفية والمعلوماتية في المسألة السورية وتداعياتها على كافة الصعد، فهل هذه الخبرة والمعرفة التي نتوخّاها لديهما أفصحت عن أن القضية السورية يمكن اختزالها بنزاع أهلي ولد بغتةً من المجهول، ووجد السوريون أنفسهم في تطاحن مدمّر، وجاءت هذه الصيحة التي أطلقها المقال لتقول لهم كفى؟
لعله من المفيد الإشارة إلى أن ما ورد في المقالة المذكورة يصلح أن يكون إجابات دامغة لكثير من الأسئلة التي أراد كاتبا المقالة تجاهلها أو تغييبها، بدءًا من مفهوم ( المصالحة – الحوار) الذي كان حاضراً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي السلمي في سوريا، وقبل أن يهتف المتظاهرون بشعار (إسقاط النظام)، ولكن هل كانت السلطات الأسدية جادّة بالفعل في محاورة السوريين؟ وحتى لا نضيع في تفسيرات وتأويلات عبارات قائد الحوارات فاروق الشرع يمكن اختصار المسألة بالعودة إلى ما قاله رأس النظام في أول خطاب له بعد انطلاقة الاحتجاجات، أمام جوقة مجلس الشعب بتاريخ 31 آذار 2011 ، إذ ما صدر عن بشار الأسد في الخطاب المذكور هو أبلغ من أي تأويل آخر.
ولو استعرضنا المحدّدات التي وضعها الكاتبان للحوار أو المصالحة، وهي محدّدات جيدة للقراءة المجرّدة، ولكن ما يحول دون تجريدها أو تبرئتها أنها تأتي في سياق يركّز النظر إلى تداعيات المشكلة ويتعمّد تغييب أصلها أو جذرها الحقيقي، فالمفقودون والمخطوفون والمسجونون الذين يطالب المقال بالبحث عن مصيرهم، فهؤلاء ليسوا عشرات بل مئات الآلاف من السوريين، وإذا كان من الصحيح أن هناك أكثر من جهة مارست الخطف والسجن والتغييب في سوريا، إلّا أن هذا لا ينفي أن أبرز هذه الأطراف وأكثرها إجراماً هو نظام الأسد، ولا تمكن المقارنة بين أعداد المعتقلين والمغيبين في سجون الأسد بسواه من القوى أو السلطات الأخرى التي أجرمت بحق السوريين.
مئات الآلاف من السوريين والسوريات، ممّن هم في السجن أو ماتوا تحت التعذيب أو مايزال مصيرهم مجهولاً، هؤلاء جميعاً، كما أهلهم وذووهم، كما عموم السوريين يعلمون جيداً أن نظام الأسد هو المسؤول عمّا حل بهم وليس أحداً آخر، فالذي أجرم بحقهم ليس مجهولاً، والمطالبة بالكشف عن مصير هؤلاء وإخلاء سبيل الأحياء منهم هي حق مشروع، والمجرم ينبغي أن يحاكم على فعلته، لا أن يكافأ بمصالحته، إلّا إذا اعتقدا صاحبا المقال أن بشار الأسد يمكن أن يعتذر في يوم ما من السوريين، وعلى وجه الخصوص من أهالي المعتقلين والمغيّبين.
جلاء المواقف لا يعني شيطنتها
ومن المحدّدات التي يؤكّد عليها صاحبا المقال هي أنه (لا يمكن لأي مصالحة أو حوار أن تكون حدثاً في زمن محدّد، بل هي عملية طويلة ومضنية) ولعله من الطريف في الأمر أن الكاتبين ذكرا اللجنة الدستورية كمثال على مسار المصالحة أو الحوار، وهذا يعني أن هذه اللجنة التي تبحث في إيجاد دستور جديد للبلاد إنما تمضي في طريقها الصحيح، ويجب ألّا يضجر السوريون من الانتظار أو الترقب، كما عليهم أن يتفهّموا أن مماطلة نظام الأسد وعدم جدّيته في التفاعل مع مسار اللجنة الدستورية ومحاولته الرهان على كسب الوقت للمضي في قتل السوريين، عليهم أن يتفهّموا كل ذلك باعتباره محدّداً أساسياً لأي حوار ناجح. علماً أن القرار الدولي (2254) والذي يحيل بدوره إلى قرار (جنيف1 وإلى القرار 2118) والذي لا يرى الكاتبان حلّاً عادلاً من دونه، يضع أطراً زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية السياسية ولا يتركها مطلقة في المجهول.
ثمة حرص واضح لدى الكاتبين على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وحثّ الجميع على العمل للحيلولة دون تقسيمها، وهذا ما يشاطرهما فيه معظم السوريين، وهو بالتأكيد حرصٌ نابع من إحساس كبير بالمسؤولية ينمّ عن إيمان عميق بحب سوريا والسوريين، ولئن كانت الدعوة إلى الحوار أو المصالحة تجسّد منهجاً حضارياً لحل المشكلات والمعضلات التي تنتاب حياة الشعوب، إلّا أن هذا النهج الحضاري يقتضي أيضاً تسمية الأشياء بمسمّياتها وعدم تعميم المسؤوليات وتغييب أصل المشكلة وبالتالي المساواة بين الضحية والجلاد، فالمصالحة ينبغي أن تهدف إلى إنصاف الضحية أولاً، وليس مكافأة المجرم، ومن هنا كان من المفترض أن يقول الكاتبان: إن نظام الأسد الذي رفض الحوار وآثر العنف ضد شعبه هو من يتحمل وزر تقسيم البلاد.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا