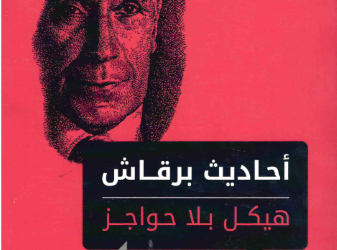عبد الرحمن الجندي
“أهُناك حياةٌ قَبْلَ الموت”؟
تذكرت هذا البيت للشاعر الراحل مريد البرغوثي بينما كانت الأعلام الفلسطينية ترفرف فوق رأسي. كانت هذه أول مَسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بيتسبرغ منذ بدء المجازر في غزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقد رفع المتظاهرون لافتاتهم تضامناً: أنهوا الاحتلال! أوقفوا إطلاق النار، الآن!
كان هذا اليوم أيضًا بمثابة أول مسيرة أشارك فيها منذ اعتقالي قبل 10 سنوات في القاهرة احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في العام 2013. وبدأ منظمو حدث بيتسبرغ، وهم من أصول عربية، خطاباتهم بالتنديد بالهجمات التي لم يكونوا قد تعرضوا لها بعد، وإنما توقعوها. أطبقت فكيَّ وأنا أستمع إلى المقدمة الطويلة: نحن العرب أناس محترمون، متحضرون، مسالمون. نحن لسنا معادين للسامية ولا أولئك المتوحشين الذين يزعمون أننا نكونهم.
وسرعان ما قاطعت تناغم تجمع اليوم فجأة صرخة -من زوجتي. التفتُّ في الوقت المناسب لأرى أن رجلًا أميركيا أبيض ضخمًا وأصلع قد طرحها هي والعديد من المتظاهرين الآخرين أرضًا. ورفع إصبعه الوسطى بينما تدفق تيار من الإهانات والشتائم من فمه. وفي نهاية المطاف، حاصرَته مجموعة من المتظاهرين، ودفعوه نحو الشرطة المتواجدة في الموقع. كانت تلك النظرة في عينيه، أكثر من أي شيء آخر، هي التي لن أنساها أبدًا. ليس الكراهية، ولا العنف -اللذين يمكن أن أتحملهما- وإنما الافتقار إلى التردد، والثقة بأنه لن يوصف أبدًا بـ”الإرهابي” أو “الهمجي”. إننا نحن فقط الذين سيواجهون دائمًا هذه الاتهامات من بين كل الناس.
في الأسابيع التي تلت منذ ذلك الحادث، ظلت عيناي، مثل كثيرين آخرين حول العالم، ملتصقتين بشاشات الأخبار. يعاني قطاع غزة من القصف العنيف والحصار الكامل. وفي الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، قطع الإسرائيليون إمكانية وصول المياه والكهرباء والوقود إلى غزة. ووفقًا لوزارة الصحة في القطاع، تجاوز عدد القتلى هناك 20.000 فلسطيني -وهو رقم لم يسبق له مثيل خلال حوالي 75 عاما من الاحتلال.
بينما أتصفح الإنترنت، وأحاول -وأفشل في- العثور على أي أثر للأخبار السارة، أعود إلى البرغوثي، الذي رحل عن الدنيا في العام 2021:
“أتلمَّسُ أحوالي منذ وُلدتُ
إلى اليوم،
وفي يأسي أتذكَّرُ
أن هُناك حياةً بعدَ الموتِ..
هُناك حياةٌ بعد الموت،
ولا مشكلةَ لديّ
ولكنّي أسأل:
يا الله
أهُناك حياةٌ قَبْلَ الموت”؟
على مدى الشهرين الماضيين، شهدنا حملة عسكرية يصفها عدد متزايد من الباحثين بأنها إبادة جماعية. وشهدنا أيضًا تغطية إخبارية متحيزة، إلى جانب تواطؤ أميركي في المذبحة، بينما يقف معظم بقية العالم متفرجًا على الجوانب.
إننا، كعرب، نطرح أسئلة جوهرية حول مكانتنا في العالم. وقد بدأنا ندرك أنَّ كوننا مستطرَحين، قابلين للتخلص منا، لا يمثل فشلًا للنظام العالمي؛ إنه في الحقيقة إحدى وظائفه الأساسية.
في كتابه “كل رجال الباشا”، يكتب المؤرخ مصري المولد خالد فهمي عن أول نسخة لما نعرفه الآن بجواز السفر المصري -“التزكرة” (التذكرة)، وهو مصطلح يعود إلى العصر العثماني يعبر عن بطاقة الهوية. في أوائل القرن التاسع عشر، في ظل الحكم العثماني لمحمد علي باشا، من أجل ردع الفلاحين المصريين عن ترك قراهم وتنظيم حركتهم بشكل أفضل، فرضت السلطات أن يحمل كل شخص “تزكرة”: وثيقة تتضمن اسم حاملها، ووصفه الجسدي، واسم الأب، واسم القرية. ومن دونه، سيواجه الناس احتمال إعادتهم إلى القرى التي أتوا منها.
اليوم، “التزكرة” هو اسم الوثيقة التعريفية التي يحملها كل سجين مصري معاصِر خلف القضبان. وأنا أعرف هذا من التجربة. طوال ست سنوات وثلاثة أشهر، تنقلت في سبعة مراكز احتجاز مصرية، وأنا أقبض في يدي على البطاقة الصفراء البالية التي سجَّلت بياناتي الشخصية، ومهام الزنازين، وتفاصيل الأحكام، وسجلات العقوبات الإضافية، بدءًا من الحبس الانفرادي وحتى منع الزيارة. وتلخص “التزكرة”، التي تُردد صدى أصولها القديمة، تنظيم الدولة لجسدي.
اليوم، ما تزال جوازات السفر العربية والهويات التي تمنحها تلعب دورًا مماثلاً، سواء في داخل الدول العربية أو في أي مكان في العالم. في وطني، أنا مدرك تمامًا لحقيقة أن جسدي قابل للاستهلاك. ومع ذلك، سوف تكون لأي كيان غربي قيمة أكبر بكثير هناك. في كل مرة تقوم فيها السلطات بإيذاء مواطن غربي، فإنها تواجه استهجاناً دولياً. وعلى سبيل المثال، ما يزال القتل الوحشي للباحث الإيطالي جوليو ريجيني في العام 2016، يطارد هذه السلطات حتى يومنا هذا. وتشير الأدلة الدامغة إلى أن قتلته كانوا من أفراد قوات الأمن المصرية. وقد علقت والدة ريجيني على قضيته قائلة: “لقد عذبوه وقتلوه كما لو أنه كان مصريا”.
هكذا تكون أجسادنا، التي تُكسَر بلا ثمن، مكسورة في أغلب الأوقات.
عندما هربتُ من مصر في العام 2020 بعد إطلاق سراحي من السجن، سعيت إلى ولادة جديدة: إلى أن يتم الاعتراف بي كجسد يعاني من العواقب. لم تكن لدي أي أفكار رومانسية حول الحلم الأميركي؛ لقد واجهت في كثير من الأحيان الفكرة المتعالية القائلة بأن هجرتنا تكون سعيًا وراء قيم عليا، وليس هروبًا من الفوضى التي أحدثتها الحروب التي فرضتها علينا الولايات المتحدة، أو الزعماء والديكتاتوريات العسكرية التي نصبتها واشنطن علينا وما تزال تدعمها، أو الدمار البيئي الذي تسببت فيه الولايات المتحدة.
لكن هذين الشهرين تجاوزا حتى أكثر كوابيسي حلكة. ما يزال حمل اسمٍ عربي يضفي عليّ سلسلةً جديدة من الألقاب؛ نسبًا يبدأ بـ”الآخر” وينتهي بـ”الحيوان البشري”.
بينما أتصارع مع وضعي في العالم، يشخص أصدقائي الأميركيون محنتي على أنها اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن صدمات السجن. لم أفهم قط سبب الاستفزاز الشديد الذي يثيره فيّ مصطلح “اضطراب ما بعد الصدمة” إلى أن قرأت كلام سماح جبر، رئيسة خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية. في مقابلة أجريت معها في العام 2019، قالت أن مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة، بجذوره في الفكر الغربي، يتطلب “قبل وبعد” -وقتًا قبل بدء الصدمة ووقتًا بعد انتهائها. ومع ذلك، بالنسبة للكثير من العرب، تشكل الصدمة واقعًا مستمرًا ومتوارثًا بين الأجيال.
ليس ثمة ما قبل أو ما بعد بالنسبة لنا. إن إجهاد الصدمة هو الحياة. عندما تلتقي عيون عربيين في المنفى، يكون هناك اعتراف صامت بأن “تذكرتنا” الخاصة تتجاوز الزمن وقضبان السجون والحدود الوطنية. إننا نحمل اغترابًا مدمجًا ليس في جيوبنا فحسب، وإنما أيضًا في الخطوط المحفورة التي على وجوهنا وفي نخاع عظامنا.
اليوم، أتحرك مسكونًا بفراغ عميق نتيجة لسلسلة من الأحداث المأساوية: الطعن المروع المميت للطفل الأميركي الفلسطيني وديع الفيومي البالغ من العمر 6 سنوات في إلينوي؛ إطلاق النار على طلاب الجامعات الفلسطينيين هشام عورتاني وكنان عبد الحميد وتحسين علي أحمد في ولاية فيرمونت؛ وبحسب ما ورد استهدفت عملية صدم وهرب طالبًا بجامعة ستانفورد من أصل سوري يُدعى عبد الوهاب عميرة. والقائمة تطول.
فكرة الموت في حد ذاتها هي شيء أستطيع أن أتقبله. نحن العرب نعرف الموت. لقد كبرنا معه، وتعرفنا إليه، وتعلمنا أن لديه ذائقة خاصة لأجسادنا.
هذا العالم لم يُبنَ قط لاستيعابنا. وحتى في أكثر الدوائر تقدمية، فإننا نعتبر اضطرابًا في طبيعة الأشياء لا يمكن التسامح معه إلا إذا بقينا نموذجًا للعرب المرمَّزين: مستساغين للأكل وخجولين، نقدم الإدانات كشرط مُسبق قبل المطالبة بإنسانيتنا. حلفاؤنا قليلون، والمقربون منا أقل. ونحن نفهم هذا الآن.
بين الأوطان التي سحقتنا وبلدان المنفى المتعطشة لفعل ذلك أيضًا، يبدو أحيانًا أنها لن تكون هناك أبدًا حياة قبل الموت. وإذا كان هذا هو ما أشعر به أنا، فإنني أحاول أن أتخيل محنة الفلسطينيين في غزة. في ثانية، ثمة جسد يتنفس، وسقف. وفي الثانية التالية: أطراف مشوهة، وركام.
خوفًا من هذا الموت الوشيك، أسكن في الموت. وأتساءل مثل البرغوثي: هل سأعرف الحياةَ في أي يومٍ قبله؟
هل سنفعل؟
لا أملك الإجابة. لكنني أعرف أن واجهة التفوق الأخلاقي الغربي قد انهارت. اليوم، نحن العرب نتخلص من دونيتنا الداخلية ونحاول شق طريقنا للعودة إلى اللغة والتاريخ: لغتنا وتاريخنا. نتجمع حول حزننا الجماعي وأنيننا الحلقي الذي له نسيج أحرف العين والخاء في أبجديتنا.
في هذه الحياة التي ليست حياة، لم نعد نناشد العالم أن ينظر إلينا كبشر. إننا نتعلم أن نرى بعضنا بعضًا كذلك بدلًا من ذلك، -وأن نجعل هذا كافيًا.
*عبد الرحمن الجندي: كاتب مصري وسجين سياسي سابق، وهو زميل ديتريش في برنامج الدراسات العليا للكتابة الواقعية بجامعة بيتسبرغ.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Arabs are forced to question our place in the world
المصدر: (الواشنطن بوست) /الغد الأردنية