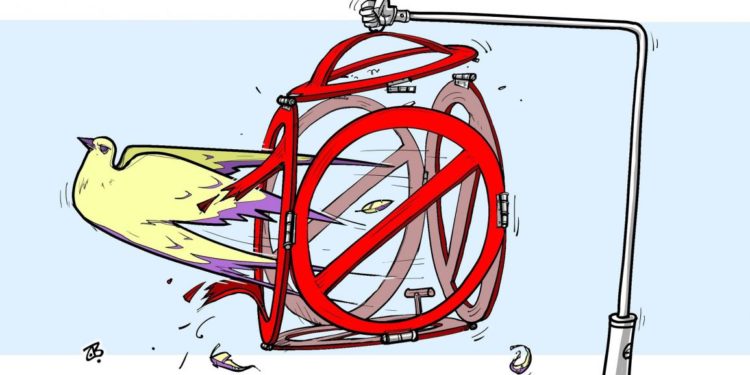برهان غليون
ما من شك في أنّ “العربي الجديد” تمثّل قصةَ نجاحٍ ربّما لم يكن أصحابها أنفسهم يتوقّعونها، فقد تحوّلت، في أعوام قليلة، إلى واحدةٍ من أبرز الصحف اليومية المتداولة عبر الحدود العربية، والمفتوحة، لكُتّاب ومثقّفين ومناضلين من مختلف الأقطار والاتّجاهات والأفكار. وفرضت نفسها أفضلَ منبرٍ للحوار بين نُخبَةٍ من مثقّفي جيل الثورات العربية.
لم يكن هذا النجاح وليد المصادفة، وإنّما نتاجَ رؤيةٍ مُتجدّدة للأحداث، ومحاولة جريئة للردّ على التساؤلات والإشكالات، التي طرحها (ولا يزال يطرحها) فشل أنظمة الحكم والإدارة العربية خلال نصف القرن الماضي في تلبية تطلّعات الشعوب، ما أدّى إلى انهيارها، كما تشير ثورات العقد الثاني من هذا القرن.
أمّا أنا، وقد عايشتُ مشروع صحيفة العربي الجديد منذ نشأتها، فكانت أو كنتُ أرى فيها، محاولةً مزدوجةً لمراجعة أخطاء خيارات (واستراتيجيات) الحقبة السوداء التي عاشتها الشعوب العربية خلال نصف القرن الفائت، وتهافت طروحاتها، وإخفاقها، من جهة، ولتجديد ما أسمّيه “الخيار العربي”، الذي ظهرت أول محاولات تجسيده في الستينيّات من القرن الماضي، عندما توافقت شعوب العالم العربي، للمرّة الأولى، على برنامج عمل واحد، بنودُه الرئيسة: انتزاع القرار المستقلّ وتصفية ما تبقّى من آثار السيطرة الاستعمارية القديمة، وإجلاء القواعد العسكرية الأجنبية البريطانية والأميركية والفرنسية التابعة لها، ومواجهة الأحلاف العسكرية المفروضة من الولايات المتّحدة وبريطانيا (حلف بغداد ومبدأ أيزنهاور)، التي هدفت إلى زجّ الشعوب العربية في الحرب الباردة، والاستعاضة منها بالتضامن العربي، وبقدر الإمكان، بتجمّع الأقطار العربية، بعضها أو أكثرها، في وحدةٍ أو تحالفٍ يساعدها منفردةً ومجتمعةً في تعزيز استقلالها، بالإضافة إلى تدشين ثورة صناعية واجتماعية تهدف إلى التغلّب على التفاوت الطبقي الصارخ، وتحرير الريف من السيطرة الإقطاعية وشبه الاقطاعية، وإدماج نُخَبِه المُهمَّشة في الدورة الاقتصادية والثقافية والسياسية، وهو الشرط الأول لتكوين جماعةٍ سياسيةٍ حديثةٍ، أي أمّة موحَّدة ومتفاعلة ومتساوية.
لا الدولة ولا الوطنية ولا الديمقراطية ولا السلام ولا الاستقلال ولا التقدّم، مكتسبات ناجزة، إنّها معاركُ دائمةٌ، والصحافة أحد أبرز ساحاتها
لا يعني تجديد الخيار العربي (وليس هدفه) العودة إلى خيارات (ومشاريع) الخمسينيّات والستينيّات الوحدوية أو الاشتراكية التي أظهرت فشلها، إنّه يعني إعادة تقييم، أي نقد وتقويم هذا الخيار لبناء مشروع جديد يجيب عن السؤال، الذي يطرح علينا بعد نصف قرن من التخبّط والفشل والإخفاق: هل يمكن أن نستفيد من إرثنا المُشترك التاريخي والثقافي، ومن الموقع الجيوسياسي، لا للاحتراب والتناحر، وتغذية العداوات ومشاعر الكراهية بين الشعوب، وإنّما لتعزيز التعاون وزيادة فرص نجاحنا، منفردين ومجتمعين، في مواجهة حالة الانهيار الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي والثقافي، التي صرنا إليها، ولمواجهة التحدّيات الضخمة التي تواجهنا؟… من الواضح أنّ الأمرَ لا يتعلّق هنا بالدفاع عن هُويَّة قوميّة أو تأكيد انتماء مشترك أو البرهان على وجود أمّة واحدة أو أمم مُتعدّدة، وكلّها إشكاليات عفا عليها الزمن، وإنّما بوجودنا شعوباً مستقلةً حيّةً وفاعلةً يدعم بعضها بعضاً في منطقة أصبحت مسرحَ صراع مفتوحٍ تتقاذف فيه الإمبراطورياتُ الضخمةُ الأقطارَ الصغيرةَ بإقدامها، كما يتقاذف اللاعبون الكرةَ في ملاعب كرة القدم الشعبية.
يكفي لإدراك أهمّية إعادة طرح هذا الخيار أن نقارن بين ما عرفته حقبة الخمسينيّات والستينيّات من تضامن فاعل بين الشعوب العربية في مواجهة الضغوط الأجنبية، ومن إرادة قوية للتقدّم في صعيد التنمية الصناعية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وانتشار القيم والفِكَر التحرّرية، وانحسار الأيديولوجيات السلفية والانطوائية، وما شهدناه بعد السبعينيّات من أزمات وطنية واجتماعية وسياسية، كان لها الأثر الأكبر في انتشار الفوضى، وتعميم الفساد، واستفحال العنف، واليأس، والخراب.
كانت أهمّ منجزات خيار الانفصالية وتسعير الخلاف، بل العداء بين الأقطار العربية العودة المُظفّرة لعقود الوصاية والحماية الخارجية، وإعادة زرع المنطقة بالقواعد العسكرية الأجنبية أكثر من قبل، وانتشار الحروب الداخلية والأهلية، بما في ذلك الحروب التي تشنّها إسرائيل لتوسيع دائرة استيطانها ونفوذها الإقليمي، وتجذّر حكم الأوليغارشيّات العسكرية، وتحالف المافيات، إلى حدّ الاعتقاد بحقّها في توريث الدولة ملكيةً عقاريةً. ومن هذه “المنجزات” دخول طهران وجمهوريتها الإسلامية في التنافس على السيطرة الإقليمية، عبر مليشياتها الخاصّة، التي أصبحت تهدّد مصيرَ شعوبٍ عديدةٍ في المنطقة من العراق إلى اليمن إلى سورية إلى لبنان. ومنها على الصعيد الاقتصادي، التراجع عن مشاريع التنمية لصالح سيطرة الاقتصاد الريعي وأسواق المضاربة وهدر الموارد المحلّية، ومن ثمّ تردّي الأوضاع المعيشية، وتفاقم الاستقطابات الاجتماعية إلى حدّ القطيعة بين القلّة الغنيّة، المُحتكِرة لجميع الثروات، المادية والمعنوية، والأكثرية المُهمّشة والمُستبعَدة من كلّ قيمة ومستقبل واعتبار.
لم يُعزّز خيارُ الالتحاق من جديد بالسياسات الغربية، وتبنّي الخيارات النيوليبرالية اليمينية، وتسفيه فكرة التعاون والتضامن العربيَّين، كما كان يدّعي أصحابه تقوية شرعية النظم السياسية وتعميق الولاءات الوطنية وإلهام الشعور بالمسؤولية العمومية لدى الحاكمين والمحكومين، ولا ساهم في تأكيد حكم القانون وزيادة فرص الانتقال نحو الديمقراطية، كما لم يُقدّم أيّ حلّ للمسألة الفلسطينية. لقد أنتج بالعكس، مزيداً من الهزائم والنكسات العسكرية والأطماع التوسّعية الإسرائيلية، ومن انتشار الحروب الداخلية والقلاقل والاضطرابات، ومن تغوّلٍ لا سابق له لأنظمة الحكم الاستبدادية. وهذا ما أطلق ثورات الربيع العربي، التي كانت الردَّ الشعبيَّ على فشل الخيارات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية، التي تبنّتها النُّخَبُ الحاكمةُ في العقود الخمسة الماضية.
استُخدم فشل الوحدة المصرية السورية في العقود الماضية لتسفيه الرهان على أيّ شكلٍ من التعاون أو حتّى التضامن بين أقطار تنبض شعوبها بعواطف واحدة
بالتأكيد، ما كانت مراجعة هذه الخيارات ضروريةً لو كان التحدّي يتعلّق ببناء فنادقَ سياحيةٍ سبع نجوم، لكنّ الأمر يختلف إذا كان هدفنا الردَّ على الخراب العميم الذي طاول منظوماتنا الإنتاجية والسياسية والثقافية، وتفاقم العجز عن تأمين الحاجات الأساسية لأغلب السكّان، وتجنّب الثورات الدورية، التي تنذر بأن تكون أكثر دمويةً بكثير في المستقبل، ومواجهة مخاطر التصحّر والشحّ المائي والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، التي تتهدّد منطقتنا أكثر من أيّ منطقة أخرى، ومعالجة الجوائح والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وتنامي معدّلات البطالة والهجرة ونزيف الأطر العلمية والتقنية. وليس أقلَّ من ذلك أهمّيةُ توفير وسائل الدفاع الذاتي وتطوير الصناعات الدفاعية التي تضمن الحفاظ على الأمن والسلام والاختراقات الأمنية في منطقة حسّاسة تتنازع السيطرة عليها التكتّلات الدولية والإقليمية، القديمة والصاعدة، من الصين إلى إيران، مروراً بالولايات المتّحدة وروسيا وأوروبا والهند، وغيرها.
تحتاج مواجهة ذلك كلّه إلى خيارات كُبرى، وخططٍ طويلةِ المدى، وتنسيقِ السياسات بين الأقطار، وتجميعِ الطاقات المادّية والصناعية والعلمية والتقنية في مستوى مناطقَ بأكملها، وتجاوز الانكفاء في حدود وطنية أصبحت ضيّقةً جدّاً لتوفير شروط التنمية الحضارية، وتطوّر قوى الإنتاج في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
للأسف، استُخدم فشل الوحدة المصرية السورية في العقود الماضية لتسفيه الرهان على أيّ شكلٍ من التعاون أو حتّى التضامن بين أقطار تنبض شعوبها بعواطف واحدة، وترى في تضامنها قوّةً لها، في وقت سعت فيه أكثر الدول، وفي مُقدّمها الدول الصناعية الأوروبية، إلى تجاوز خلافاتها ونزاعاتها التاريخية، وإلى تشكيل اتّحاد ضَمِنَ لها البقاءَ والمنافسةَ في سوق عالمية مفتوحة، والحفاظَ على الاستقرار والأمن والسلام في بيئة دولية مضطربة. هكذا وُضِعَت الشعوب العربية الفقيرة والضعيفة أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الوحدة الشاملة، التي تعني الانصهار وتغييب الهُويَّات القُطرية أو المحلّية، وهي مستحيلة، أو الانفصال الكامل وتغذية مشاعر العداء والكراهية المتبادلة للحفاظ على النظم القائمة وانفراد كلّ منها بتقرير مصير شعبها، وإخضاعه بجميع الوسائل، بمعزلٍ عن أيّ ضغوط شعبية خارجية عربية، وهذا ما نعاين بعضَ تجلّياته في ردود الشعوب العربية، أو بالأحرى انعدام ردودها على ما يتعرّض له فلسطينيو غزّة من حرب إبادة جماعية، وعلى مذابح الأسد الوحشية في سورية.
أكّد التاريخ أنّ بديلَ الخيار العربي هو الخيار الغربي وإسرائيل. ولا يعني هذا عداءً للغرب، ولا للشرق، وإنما تحويل الصفر العربي المكرّر إلى رقم
والواقع أنّ استبعاد هذا الخيار، الذي تسعى إلى تطبيقه الدول الأكثر تقدّماً، في آسيا وأفريقيا بعد أوروبا، لتواجه تحدّيات المنافسة الدولية المفتوحة، لم يرتبط بأيّ هدف وطني كما يدّعي أنصاره، وكما برهنت خمسةُ عقود ماضية عليه. لقد كان هدفه إجهاضَ الحركة الشعبية واستعادة النُّخَب المحلّية السلطةَ المطلقةَ بمعونة القوى الأجنبية وحمايتها، وقطع الطريق على أيّ فرصة للتقدّم نحو الديمقراطية، بل حتّى المشاركة الشعبية في أدنى صورها. هكذا أمكن لهذه النُّخَب المحلّية، التي سرعان ما تحوّلت إلى عصبة من المنتفعين أن تستعيد مواقعها في السلطة، وتدحر شعوبها، كما أمكن للقوى الغربية أن تستعيد نفوذها وتضاعفه في البلدان التي أجبرت سابقاً، تحت ضغط الشارع الشعبي، على الرحيل عنها. وقد لا قى هذا الخيار (ولا يزال يلقى للأسف) الترحيبَ والاستحسانَ من كثيرين من المثقّفين ورجال السياسة العرب، الذين ارتبط الخيار العربي في وعيهم بالناصرية، أو الذين اعتقدوا أنّ قطع أواصر القُربى بين الشعوب العربية شرطٌ ضروريٌّ لتقوية الدولة الوطنية، وتحقيق الديمقراطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وهذا ما أظهر التاريخُ القريبُ نقيضَه، تماماً كما أكّد أنّ بديلَ الخيار العربي هو الخيار الغربي، ويعني أيضاً الخيار الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار الخضوع لسياسة الابتزاز الإيرانية، وربما غداً الهندية. ولا يعني هذا عداءً للغرب، ولا للشرق، وإنما تحويل الصفر العربي المكرّر إلى رقم.
باختصار، إعادة طرح مسائل التحرّر والتنمية، والتحوّل الديمقراطي، والمشاركة في بناء أجندة السياسة العربية للسنوات القادمة، لا تقتصر على نقد خيارات الحقبة السوداء الماضية. فلم تنجم هزيمة الحركة الشعبية في الخمسينيّات والستينيّات عمّا واجهته من مقاومات داخلية، وما تعرّضت له من حروب وانقلابات وتحالفات خارجية، أجهزت عليها بعد أقل من عقدين من الزمن فحسب، وإنّما أيضاً، وربما بشكل أكبر ممّا اعترى تكوينها من ضعف الرؤية، ونقص الخبرة، وسوء التحليل، وغلبة العاطفة على العقل، الذي ميّز معظم القوى التي تصدّت لمهام هذه المرحلة، ولعملية التغيير والتحديث، التي كنا ننتظرها منها. هذا ما كنت ولا أزال أرى فيه الرسالة الرئيسة لصحيفة العربي الجديد.
وأخيراً، لا الدولة ولا الوطنية ولا الديمقراطية ولا السلام ولا الاستقلال ولا التقدّم، مكتسباتٌ ناجزة، إنّها معاركُ دائمةٌ لا نتوقّف عن خوضها، والصحافة هي أحد أبرز ساحاتها. لذلك، لا يسعنا في الختام إلّا أن نُحيّي صحيفتنا المتميّزة ومحرّريها وكُتّابها، الذين يدافعون بأقلامهم عن حرّيتنا، ويحيون الأمل في مستقبل بلداننا.
المصدر: العربي الجديد