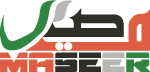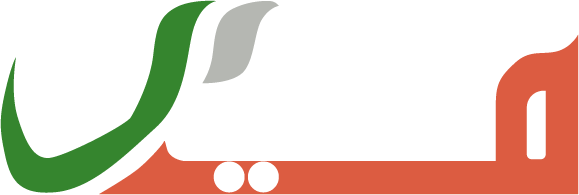إذا كان اللبنانيون أول وربما أكثر العرب، الذين اختبروا تجربة المهجر منذ نهايات القرن الثامن عشر ، فقد نقل لنا أدباءهم الكبار أمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وغيرهم، إرث إحيائي مشبع بالمفارقات المؤلمة بين الوطن الأم وحياة المهجر، تمور المسافات الشاسعة بينهما بأحاسيس الفقد والحرمان، وأنهار من حنين تتدفق من ذاكرة ملتاعة لا تكف عن استعادة الفردوس المفقود. مع كل ذلك لم يتحول واقع المهجر “وقد أضحى مع تعاقب السنين مستقراً لأجيال لبنانية متتالية” إلى منفى ذات دلالات وأسئلة وهواجس تتجاوز بضراوتها في زمننا الراهن، ما كشفته تجارب المهجر من تفارقٍ بين الغربة في تعبيراتها الفردية عن أحوال ومشاعر الغرباء، والمنفى كظاهرة أنطولوجية بات لها دور أساسي، في إعادة تشكيل مصائر جماعات قومية أو وطنية أو عرقية. ليس لأن المنفى تجربة قسرية تفتح على أزمنة مجهولة، أو لارتباطه بحالات اقتلاع وتهجير جماعي، لم تعد التراجيدية الفلسطينية في السياق العربي شاهداً حصرياً عليها، بعد أن طوت المنافي في زمن الثورات والصراعات الدموية، جموعاً هائلة من المنفيين العرب، ومثالهم الصارخ ملايين اللاجئين السوريين. ثمة حقائق ومتغيرات عميقة تفرض إعادة تعريف أوطان لم يعد الحنين والبعد عنها، قرينة على انتماء هويّاتي لها غير مشكوكٍ فيه. إذ أن ضمور اليقين بالعلاقة الوشيجة مع الوطن الأم، وتخلّع التصورات الفردية والجماعية عن أزلية تلك العلاقة، يفتح على صراع هويّاتي معقد، بين تآكل وضمور الهويات الأصليّة للمنفيين، ومحددات استيعابهم وإدماجهم في سياسات الدول التي لجأوا إليها. إنها صورة المنفى الحديث في اضطرابه وتمزقاته الجمعيّة التي تتعدى مشاعر الوحدة والعزلة الفردية، كما طبعت تراث المنفى الكلاسيكي. ما يدفعنا إلى النظر ملياً في التحولات التي طرأت على ” تعريف الوطن والوطنية ” في مخيلة المنفيين الجدد، والتي تتجاوز حدود التمييز بين المُهاجِر والمنفي، فلم يعد مجرد عبور الحدود بين مجموعة قومية واجتماعية وأخرى، يتعلق بالموقف من ثقافة البلد المُضيفة، إذا كان سلبياً من منظور المنفي، أو إيجابياً من منظور المُهاجِر، ولذلك يرى جان محمد ” أن غياب الوطن التي تشدد عليها فكرة المنفى، يتضمن تمزقاً لاإرادياً للعلاقة بين الذات الجمعية للثقافة الأصلية والذات الفردية “. يبدو أن اعتمال هذا التمزق في حالة المنفيين العرب، مما لا يمكن اختزاله بصور الألم والخذلان الناجمة عن مآلات الأوطان العربية. ما هو أبعد من ذلك يرتبط اليوم بذاكرة جمعيّة، تُحيل ما أمسى عليه المنفيين، إلى الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى الفرار من أوطانهم، وتنكب دروب المنافي كخيار قسري، فرضته عليهم أوطان تلفظ أبناءها بكل قسوة وصلف. ولأن المنفى والذاكرة مجدولان معاً، فإن ما يتذكره المرء عن الماضي وكيفية تذكّره، هو ما يحدد الطريقة التي نرى بها المستقبل “حسب تعريف فرانز فانون للمنفي”. بهذا المعنى تظلل الذاكرة المجروحة عن الماضي، وطن المستقبل في رؤية يلفها التشاؤم والغبش، تجد في الهروب إلى شرنقة الذات محاولة للانسحاب من ماضٍ، إلى مستقبل مغاير يفتح سبيلاً للبرء من وطن عالقٍ بين اليأس وتقادم الذاكرة. يفيد هذا التحليل حول ثنائية المنفى والذاكرة، لنتعرف أكثر على صلات النَسب بين بيئة المنفى، وتأثيرها على وعي المنفيين حيال قضايا وطنية وعالمية، لاسيما أن حقائق ومعطيات جديدة، كشفت فوات الانطباعات التقليدية في تفسير الفجوة بين الوطن الأم والمنفي. لنأخذ اللجوء الفلسطيني كمثال على تحولات المنفى في وعي الفلسطينيين إثر النكبة الأولى، والمنفيين الجدد منهم إثر النكبة السورية، ففي النكبة الأولى التي تسبب بحدوثها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، ساهم المنفى في إعادة بناء الهوية الوطنية، من أجل تحدي البقاء والإصرار على التمسك بالقضية في وجه عدو خارجي، يتحمل في ذاكرة الفلسطينيين مسؤولية الفصل بين الجغرافية وأصحابها، فيما أطلقت نكبتهم الثانية في سوريا، أسئلة وهواجس كبرى، عن جدوى اللجوء في بلد عربي، غدا نظامه الحاكم مسؤولاً عن تشريدهم مجدداً، وإبعادهم عن حلم العودة ليس بأقل مما صنعه العدو الخارجي. في المنافي البعيدة التي فروا إليها من الجحيم السوري، طرأ تحول كبير على علاقتهم بالهويّة الوطنية، وقد أضحت نوستالوجيا بلا مشروع وطني يعبر عنها وعن حقوقهم، وبعد أن أضحى خيارهم البحث عن منفى يستوطنون فيه، وينهي وضعيتهم السياسية كلاجئين معرضين للاستباحة والإنكار بلا نهاية. إذاَ رغم وضعية التهجير والتشريد التي تعرضوا إليها في النكبتين، وألقت بهم في ساحات المنافي، لكن اختلاف الفوارق من حيث الأسباب والأزمنة، أدى إلى محصلات وآثار متباينة جداً، لها تداعيات كبيرة على إعادة تعريف أنفسهم، كمنفيين في المرة الثانية، يفضلون مرارة الاغتراب في منافي آمنة، على قهر الموت في بلاد لم يعرّفوا كغرباء فيها. في مثل هذه الحالة بكل مفارقاتها وتناقضاتها، والتي تنطبق اليوم إلى حدٍ كبير على السوريين المنفيين وغيرهم من العرب، يصبح سؤال من يمنع العودة إلى الوطن؟ إشكالياً بامتياز طالما أنه يقترن بسؤال الجماعات المنفية عن معنى الهوية الأصلية وجدوى الارتباط بها…؟ ينبثق ذينك السؤالين على وجه التحديد من سياسات نظام دولي يتجه إلى عولمة المنافي، وتوليد سياقات من ذوبان المنفيين في عوالم لاتزال تعيق بناء هويّاتهم الجديدة. ليست العنصرية التي تتسع في الغرب مثالها الوحيد، ثمة عوامل تاريخية وثقافية ولغوية، لا تتيح لهم القطيعة مع هويات عالقة، بقدر ما تدفعهم إلى وضعية وجدانية ونفسية شائكة، خلافاً لتسوية وضعيتهم القانونية في دول المنافي كمقيمين أو مواطنين فيها بحكم القانون. لعلّ الشروخ والتناقضات الحادة التي تسمُ واقع المنفيين الحديث، تقارب من حيث تداعياتها على تعريف جماعات المنفيين لذاتها، ما حاول إدوار سعيد في كتابه ” تأملات في المنفى” الإضاءة عليه، لكن المسألة باتت تطرح على صعيد تصورات المنفيين عن مفاهيم الانتماء والهوية والوطن، مشكلات بنيوية تختلف تأثيراتها على أجيال المنافي، ومستقبل المنفى والمنفيين على وقع أوطان طاردة لأبنائها، ودول لجوء تضع اعتبارات السياسة والأمن، على حساب رؤية إنسانية مسؤولة، تنطلق من معالجة أسباب اللجوء والتهجير، ودورها في تفاقم معضلة الهوية وضياع المنفيين.
منير الربيع يتشابه دفتر الشروط الأميركي المفروض على لبنان مع ذاك المفروض على سوريا. على الرغم من دخول البلدين في...
Read more