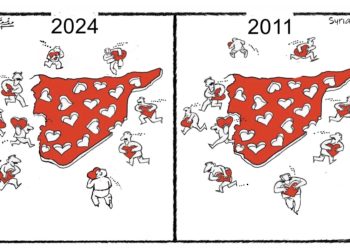أحمد الشولي
لن تُذكر دولة الأسد بعد زوالها عن سوريا بمآثر متخيلة لم تكن يوماً حقيقة أصلاً، ولن تُذكر بمساوئها العديدة فقط أيضاً، بل لعلها ستُذكر أولاً بحجم التضليل الذي مارسته طويلاً، والذي بلغ أوجه، حتى الآن على الأقل، في خضّم هذه الثورة العظيمة.
على سبيل المثال، تم بثّ فكرة في بداية الثورة تقول إن الاقتصاد السوري مستقل، تحديداً عن الإمبرياليات الغربية التي لا تستطيع أن تفعل به ما تريد، وتقول أيضاً إنه اقتصاد كفؤ وقادر على النمو والاستدامة، وبلا عجز تقريباً، إذ أنه راكم قاعدة إنتاج صناعي وازنة. وكانت هذه الإشاعة باباً لتدعيم فكرة المؤامرة التي ارتكز عليها النظام السوري في شرعنة رده الهمجي العنيف على الثورة، إذ أن كل مستقلّ، مثله، يجب تحطيمه. وتدفع بهذه المؤامرة قوى شريرة قد تكون غربية بالنسبة لجمهور من القوميين العرب، أو إمبريالية بالنسبة ليسار لا يمانع درأها من خلال إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية، أو حتى صليبية وكافرة في مخيال عن صراع حضارات مستعر منذ ألف عام أو أكثر.
ولبيان أن كل هذه الأفكار عقائديةٌ ولا تطابق الواقع في شيء تقريباً، ينبغي توضيح أن طبيعة النظام السوري الاقتصادية، ومصالح القائمين عليه والناهبين فيه، لا تتعارض مع طبيعة مصالح القوى الكبرى التي قامت الدعاية المضادة للثورة على أنها تعادي النظام القائم وتسعى للإطاحة به. بل على العكس من ذلك، قطعت الثورة سيرورة اندماج متسارعة في منظومة رأس المال المعولم، كانت تعبّر عن طموح الأسد الثاني في النمو، بعد أن تعفّن اقتصاد أبيه الحمائي القاصر.
برنامج إحلال الواردات
يعود هذا التعفن إلى أن نظام الأسد الأول اتبع نموذجاً اقتصادياً فشل لاحقاً في أغلب حالات تطبيقه عالمياً. سوريا الأسدية، كأغلب الدول النامية وحديثة الاستقلال، سعت إلى تمتين استقلالها الاقتصادي من خلال تطبيق برامج التصنيع عبر إحلال الواردات 1(ISI)، بهدف وقف استنزاف رصيد العملات الصعبة.
الفكرة الصحيحة التي قامت عليها هذه البرامج، هي أنه لا يمكن تحقيق تنمية دون الوصول إلى إنتاج الطاقة أو شرائها، ودون الحصول على تكنولوجيا متقدمة من الخارج. وهذه كلها لا يمكن شراؤها إلّا بالعملات الصعبة، المحدودة ضمنياً في دول ناشئة، لذلك يتوجب الحفاظ على أرصدة العملات الأجنبية، بل وتغذيتها أيضاً، لضمان الحصول على الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكون ذلك من خلال إيقاف إنفاقها على استيراد حاجات أساسية.
البديل هو تصنيع الحاجات الأساسية وطنياً، إما من خلال إنشاء قطاع عام، أو تقديم الدعم للقطاع الخاص المتواجد محلياً، أو تحقيق مزاوجة بينهما بهدف بلوغ العتبات الأولى من القدرة التصنيعية. وبالإضافة إلى خلق نمو اقتصادي يرفد الدولة بموارد ضريبية، هدفت هذه البرامج أيضاً للوصول إلى أعلى نسبة تشغيل ممكنة، آملةً أن تنمو هذه الصناعات إلى مراحل تصدير الفائض، وبالتالي رفد احتياطيات النقد الأجنبي للحصول على الطاقة والتكنولوجيا بلا انقطاع، وبلوغ مستويات تنمية اقتصادية تنقل مستوى معيشة الأفراد في المجتمع أخيراً إلى مصاف الدول المتقدمة.
راجت هذه البرامج في الخمسينيات مع موجة التحرر من الاستعمار في العالم الثالث، وأثبتت نجاحها مبدئياً من خلال إدارة الاقتصاد بوجه اجتماعي، إذ تمكنت دولٌ كثيرة من الإنفاق على الخدمات العامة والبنى التحتية، وأمّنت فرص عمل متنوعة للمواطنين، ووفّرت احتياجاتهم ورفعت مستوى معيشتهم بشكل يليق بوعود وأثمان حركات التحرر والأحزاب التقدمية إلى حد ما. تدخّلُ الدولة لإخضاع الإنتاج والاستثمار لحسابات اجتماعية، وليس لدوافع ربحية في المقام الأول، جعلها درعاً ضد تقلبات الأسعار، وسنداً لتنمية قد لا تأتي بدون الدولة، التي تستدين وتتحمل جانباً من التكاليف المصاحبة للتنمية بدلاً من القطاع الخاص، الذي لم يكن ليستثمر إن لم تضمن له الدولة دعماً مالياً وحماية من منافسة رأس مال أكثر كفاءة وراء الحدود والبحار. تحققت في تلك الفترة قفزة نوعية عالمياً في مستوى المعيشة، يمكن ملاحظتها هنا في الشكل (1) على سبيل المثال، من خلال تتبع ارتفاع متوسط الأعمار منذ الستينيات من القرن الماضي في عدة مناطق نامية حول العالم.
ولكن، تأتي برامج التصنيع الكابح للواردات مترافقة مع قيود ذاتية، كونها تنحصر أساساً في سوق الدولة. أولاً، يتشبّع السوق المحلي سريعاً من إنتاج السلع الأولية ذات الطلب محدود المرونة. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة في الدخل إلى أن يستهلك الشخص ضعفي عدد المناديل أو الأغذية المعلبة التي كان يشتريها من السوق، لكن من النادر أن يرتفع مثلاً إلى عشرة أضعاف ما كان يستهلك سابقاً، ولهذا تتشبع الحاجات من المواد الأساسية سريعاً، وتتبدد الفرصة المتاحة لرأس المال المحلي في أن يستثمر مجدداً فقط من أجل حصة سوقية صغيرة أو معدومة. يضاف الى هذا، وهو الأهم، أن البرنامج الحمائي يحافظ على نسق العلاقات الرأسمالية، من حيث استغلال الطبقة العاملة ومراكمة الفوائض، ولكنه ينزع دينامية الإنتاج الرأسمالي من خلال درء المنافسة، حيث تكون الدولة قد شيدت أسواراً جمركية ووزعت الإنتاج بين الشركات المختلفة، بل وربما وفرت دعماً في كلف التشغيل والتجهيز، بحيث يتحصل رأس المال المحلي على ربح جيد بلا مغامرة ولا منافسة. وبالتالي تنتفي الحاجة الى الاستثمار مجدداً من خلال ضمان الأرباح، وهو ما يمنع بالتالي من تعميق السوق. هذا التعميق هو الانتقال إلى صناعات بتكنولوجيا أكثر تقدماً، تبحث وراء خفض الكلفة وتحسين الجودة، وتبدأ معها سلسلة إنتاج صناعي، متدرجة، تغذي نفسها من استمرار تعميق السوق وتطوير التكنولوجيا ورفع جودة المنتجات، لتكتسب تنافسية عالمية تضمن استمرار توسّع الصادرات، وبالتالي الانتقال إلى برنامج اقتصادي تقوده القدرة التصديرية التي تملأ أرصدة العملات الصعبة، بحيث أنه إذا لم يكن مجتمعٌ ما منتجاً لتكنولوجيا متطورة معينة، فهو يمتلك من الأرصدة ما يكفي لشرائها. أغلب الدول المتقدمة تدير حسابات فوائض تجارية ومالية بفضل قاعدة صادرات تكنولوجية متقدمة، وأغلب الدول النامية تغرق في عجز تجاري يعود إلى القيمة المنخفضة لصادراتها، إن وُجدت أصلاً، أمام الحاجة إلى استيراد التكنولوجيا ذات القيمة المرتفعة.
الصعود الممكن من الحفرة
إن بناء اقتصاد ديناميكي هو مشكلةٌ حقيقية، وحّلها أمرٌ صعبٌ يتطلب تنسيق جهود إنتاج معقدة لا مجال للقفز فوقها. على سبيل المثال، الهند والبرازيل دولتان بأسواق داخلية كبرى، ومع ذلك داهمهما الوقت قبل الانتقال التكنولوجي، وذلك لأن الدولة حمّلت نفسها ديوناً هائلة لتوفير الدعم للإنتاج المحلي الأولي، وشراء الطاقة والتكنولوجيا بأسعار الأسواق العالمية، دون أن تتمكن من الوصول إلى إنتاج بقيمة مرتفعة يرفد الخزينة بالموارد والعملات الكافية. وقد أدّت هذه الكلف الباهظة في النهاية الى أزمة الديون السيادية، أي عجز حكومات عديدة حول العالم عن دفع أقساط قروض مستحقة في عقد الثمانينيات، التي صاحبها التضخم السريع وتآكل أسعار العملات. كانت هذه مرحلة الدخول في الترتيبات النيوليبرالية التي لا زلنا نعيشها إلى اليوم، وهي التخفف من الإنفاق الحكومي، وإدارة الدولة وفق سياسات مالية ونقدية متحفظة تسمح باستقرار سعري يجذب استثمارات من الخارج.
قلّة فقط من دول العالم نجحت في التحول التكنولوجي المؤسِّس لصادرات نوعية، أشهرها كوريا الجنوبية وتايوان، اللتين نجحتا في التغلب على نزعة رأس المال نحو الاستثمار سريع المردود قليل المخاطر، عبر خلق نظام حوافز للرأسماليين فيهما، بهدف توجيه الاستثمار نحو النوعية بعيدة المدى، مع عواقب مالية على من يستنكف عن هذا. ولا يمكن رد نجاح هذه التجربة في كوريا وتايوان إلى الديكتاتورية، إذ لم تفلح ديكتاتوريات البرازيل والأرجنتين في ذلك، بل وقف النظامان فيهما حائلاً أمام هذه التحولات. كما لا يمكن رده الى الديمقراطية أيضاً، إذ لم تفلح الديمقراطية المستقرة في الهند في إنجاز هذا التحول. الأمر يتطلب توازناً دقيقاً أمام سطوة الرأسماليين على المجتمع سواء في ظل الديكتاتورية أو الديموقراطية، بحيث تتحقق أفضل فرصهم في الربح ضمن برنامج تنموي يقوده اضطرادٌ دائمٌ في الصادرات، مصدره التطور التكنولوجي، ويمتّن أساس الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى المعيشة فيه.
قد تكون الوعود المضمونة بنفاذ بضائع كوريا وتايوان إلى السوق الأميركية، أكبر ميزة يقدمها هذان النظامان، وليس السطوة الديكتاتورية. بل على العكس من ذلك، انهارت السلطوية في البلدين بالتزامن مع التسارع الصناعي، بشكل يشبه تحقق الديمقراطية في أوروبا وأميركا تدريجياً، مع تمكن الطبقة العاملة من تعطيل دورات أرباح كبرى من خلال الإضراب لأجل الديمقراطية في بدايات القرن الواحد والعشرين. أما الديكتاتورية فهي تكتفي بتحقيق منافع لشرائح من الرأسماليين، تضمن من خلالها الربح والتنفيع، وتحريك الاقتصاد بهدف الاستقرار، وهي إن شاءت الدفع بهذه الشركات إلى استراتيجية ما، تنموية مثلاً، فإنها ستستند إلى تعبئة وتحفيز الطبقات العاملة، ولكنها بذلك تكون قد غامرت باستقرار سلطتها. بهذا المنطق، يأمن الدكتاتور على نفسه بأن يمرّغ مجتمعاً بأكمله في وحل التخلف الاقتصادي.
الأسدية غارت بسوريا عميقاً في الحفرة
سوريا الأسد الأول، مثل أغلب الدول النامية المحكومة من أباطرة، داهمها الوقت كما داهم الهند والبرازيل والأرجنتين. بل يظهر واضحاً في الشكل (3) أدناه أن عجزها التجاري في تلك الفترة من الثمانينيات كان يشابه عجز دول المنطقة الأربعة التي ستقود المشروع النيوليبرالي لاحقاً، أو أنها كانت قد بدأت في قيادته فعلاً (مصر، المغرب، تونس، الأردن).
ربما سمح حجم سوق سوريا الداخلي لنظامها بالاستمرار في التجربة الحمائية أكثر من تونس، التي كانت قد بدأت في تعزيز صادراتها نوعياً نتيجة أزمات سابقة؛ أو أنه وفّرَ له القدرة على استدامة الإسراف في ديكتاتوريته بالمقارنة مع نظام الأردن، الذي اضطر في الفترة نفسها للانفتاح سياسياً بعض الشيء؛ أو أن أزمة أسعار النفط في 1973 وتعويم الدولار قبل ذلك، كانا أكبر أثراً على نظام السادات من نظام الأسد الأول، ولذلك كان السادات من أول الراكبين في قطار النيوليبرالية الذي لا يزال يدهس تحت دواليبه ما تبقى من سياسات اجتماعية حول العالم.
لكن هذه كلها تمايزات ظرفية أو وقتية، وليست تمايزات نوعية. لم يكن الأسد الأول كفؤاً في الواقع، بل اعتاش على مساعدات وفّرتها له ظروف الحرب الباردة، التي كانت المنطقة إحدى ساحاتها الساخنة دائماً. الفرق بينه وبين دول النيوليبرالية الأربعة الرئيسية في المنطقة، أنه دار في الفلك السوفييتي المناوئ، بينما داروا هم بانتظام في الفلك الأمريكي. وعندما انتهت هذه الحرب، كان الأسد الأول أبا البراغماتيين الأكبر، فهروّل إلى حفر الباطن في الكويت لقاء الرضا الأمريكي بعد أن انهار التحاد السوفييتي، وقبض مقابل ذلك تعويم نظامه لفترة استمرت حتى موته.
لم تتميز سوريا الأسدية في شيء يذكر، بل أدامت فشلاً اقتصادياً محدداً لأطول فترة ممكنة.
الوريث سعيد الحظ
جاء الأسد الثاني في عهد قلّت فيه العطايا لأن التجاذبات كانت قد تراجعت. إذ لم يعد هناك أسواق مغلقة يحميها الاتحاد السوفييتي أو الصين، وتسعى أميركا لفتحها بقوة الجيش إن لزم الأمر، وكان العراق هو الاستثناء الذي أكد القاعدة. الأول، الاتحاد السوفييتي، أصبح سوقاً مخترقة بحد ذاته، ورديئة أيضاً إلى حد بعيد. والثانية، الصين، باتت قوة رأسمالية صاعدة ومرعبة بحد ذاتها. لا لعبة اليوم لكل هذه الحكومات غير الاجتماعية التي تملأ الكوكب، سوى التذلل لرأس المال العالمي، وتوفير ما أمكن من الشروط الجاذبة للاستثمار. وهنا كان هذا الأسد سعيد الحظ بشكل استثنائي، إذ بالإضافة إلى حصوله على ميراث يشمل «الجمهورية»، فإنه ورث تلك «الجمهورية» بفائض تجاري أساسه ارتفاع أسعار النفط منذ نهاية التسعينيات.
وفرت استثنائية الحظ هذه القدرة على استمرار تعويم نظام أبيه الحمائي شديد السلطوية، فالاضطرار إلى التحولات البنيوية في منظومة الإنتاج الاجتماعي، يتطلب دوراً فاعلاً للطبقة الرأسمالية المحلية، أو على الأقل شريحة وازنة منها، تستجلب على الديكتاتور تنازلات ليبرالية يتم تشارك السلطة فيها مع النخب. وقد تمكن بشار من بدء تحول نيوليبرالي بطيء، بحيث أبقى على قبضته الأمنية حامية لتعميق فقر السوريين، وأدار الصراع الداخلي مع النخب بدل مشاركتها. فعندما كان النيوليبراليون الأربعة قد تبحرّوا في الاستدانة من الخارج، سواء من حكومات أو من السوق المفتوح، يظهر في الشكل (5) أدناه أن الأسد الثاني اختار سداد جزء بسيط من المديونية التي راكمها أبوه في سنواته الأخيرة، والتي تمكَّنَ هو من سدادها في 2002 من عائدات النفط، وكان أغلبها فعلياً مساعدات ملحقة بالقروض، ثم عاد واستدان من الخارج بالشروط نفسها في 2007، وبمستويات بدأت تقترب مجدداً من النيوليبراليين الأربعة. لكن الثورة داهمته قبل أن يتسارع هذا التحول الهيكلي الذي كان قد بدأ فعلاً.
مارس الأسد الثاني منطق التدرّج والتحول البطيء الذي اجترحه الأسد الأول للحفاظ على سلطته المطلقة بأفضل ما استطاع، حتى انكشف تماماً في الشهور القليلة الأخيرة قبل الثورة. إذ في ظل ضعف هذا النظام نوعياً، وعدم قدرته على فرض شروط في الوقت نفسه الذي لا يبدي فيه استعداداً لدفع أثمان أو تنازلات لأي طرف خارجي أو داخلي، راح يمسك بما تيّسر له من رهائن ليفاوض عليهم في غياب أي مقدرة أخرى على التأثير. لبنان، على عيوبه العديدة، كان شقيّاً بالجيرة الأسدية. فتدمير الحركة الوطنية اللبنانية والفلسطينية إبّان الحرب الأهلية في لبنان، والتدخل لصالح الفاشية اللبنانية، وحتى تأمين سطوة النظام الأردني من قبلها، كلها إنجازات يستطيع الأسد الأول ادعاءها كما إسرائيل. ولكنه عندما ذهب ليفاوض إسرائيل، وفي جيوبه لبنان وعدد من الفصائل الفلسطينية والكردية، اشترط أن على أي اتفاق أن يضمن له أن تبتل قدماه في بحيرة طبريا، عكس توصيفه لاتفاقات مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن المفرّطة. لقد وضع نصب عينيه أن يرى السوريون صلحه مع إسرائيل ربحاً، فهو لن يدفع ثمن الاستسلام الذي قد يخسر فيه شيئاً من سلطته. إسرائيل بالمقابل هي التي رأت أن الأسد يبالغ في تقدير سعره في السوق، و«حلقت له» وفق التعبير السوري الدارج، فهي لم تكن أسيرة حساباته الداخلية، بل كان انفتاحها عليه فقط رغبة من حكومة نتنياهو الأولى بإدخال سوريا على الخط، للحد من مناورات الملك حسين وعرفات، اللذين كانا يحاولان فرض شروط على إسرائيل، والتسريع بحل نهائي يستوعب اللاجئين الفلسطينيين، وهو المكسب الذي ظنّا أنه باستطاعتهما إشهاره في وجه النقد، وهذا كان أكثر مما تقبل به إسرائيل في اتفاقيات السلام معهما، أو نتنياهو على الأقل. وكان ما كان من الإهانة أن ذهب الشرع إلى كامب ديڤيد بعد أن وصل إيهود باراك إلى الحكم، وتم توبيخه من كلينتون الذي وبّخ عرفات أيضاً.
مات الأسد الأول، وورثَ الثاني السطوة على لبنان أيضاً. حاولت البرجوازية اللبنانية التي عادت لتلتقط أنفاسها بعد الحرب الأهلية بقيادة الحريري الابتعاد تدريجياً، وتكبير حصتها وتسريع اندماجها العالمي بأكثر مما رغب الأسد الثاني بالمجازفة. وحينها أعلن حربه عليها، وتكلّف كثيراً دون أن يتمكن من منع هذا الانشقاق وخسارة رصيده التفاوضي الأخير. ثم عاد إلى لبنان من بوابة «المقاومة» لتحسين شروطه التفاوضية، وهنا لا يمكن اعتبار أن من تمرّس على قهر السوريين، قد انحاز ضميرياً ضد قهر اللبنانيين أو الفلسطينيين، أو أن مقاومتهم لإسرائيل قد عنت له أكثر ممّا يستطيع هو الإفادة منه. ففي عزّ غرغرة الأفواه بترهات الممانعة، وخطاب الأسد الثاني عن «الرجال وأنصاف الرجل» بعد حرب لبنان في 2006، كان قد بدأ بالاستدانة من الخارج مجدداً، وبدأ يراكم العجز التجاري رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط لسنتين إضافيتين، وكان قد شرع في برنامج خصخصة الخدمات العامة بسرعة وضعته في منتصف الترتيب بين النيوليبراليين الأربعة، حيث تقدّم في هذا المجال على كل من مصر وتونس، كما تقدّم على لبنان الذي لم تقم لدولته المركزية وقطاعها العام قيامة تذكر.
لم يعد لدى الأسد في النهاية أوراق تفاوض ثقيلة، فالتهديد بالمقاومة لم يعد يعني كثيراً بعد أن كانت إيران، سيدة المتمنعين جميعاً، قد التقطت رسائل أوباما التصالحية. وكان أن أتى الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل شهور قليلة من الثورة إلى دمشق، بعد أن كان اتُّهم في رجولته مؤخراً، واصطحب الأسد الثاني على متن طائرته إلى بيروت ليصلح ذات البين مع القيادة اللبنانية، ويتمم تطبيع نظام الأسد مجدداً، والإعلان عن جهوزيته للاندماج التام في عالم تنظمه الرأسمالية المعولمة.
من قد يتآمر على نظام كهذا؟
على من لا يزال يعتقد بخطة محكمة للإطاحة بالأسد، أن يشرح لنا كيفية عملها التي لم يتبدد الغموض الذي يكتنفها في أي وقت، كما ويقع عليه بدايةً أن يخبرنا، نحن جموع المشككين، ما هي الحاجة أصلاً لخطة كهذه.
المصدر: الجمهورية نت