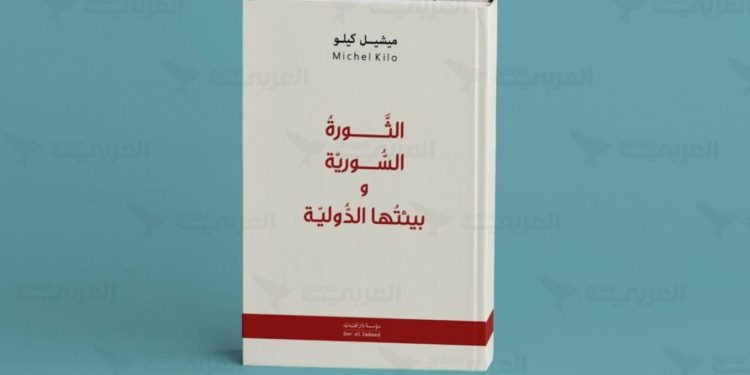عمر كوش
يقدّم الكاتب السوري الراحل ميشيل كيلو، في كتابه “الثورة السوريّة وبيئتها الدولية” (بيروت، دار الجديد، 2022)، رؤيته لما حدث في سورية منذ اندلاع الثورة وصولاً إلى 2020، من خلال تناول أحداث ووقائع جرت، واستعراض وتحليل مواقف وتدخلات مختلف القوى والدول الخائضة في الشأن السوري، وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والأنظمة العربية، وما أصاب السوريين وثورتهم وبلادهم.
تمرّد مجتمعي
ويجادل ميشيل كيلو بأن “ما وقع في سورية أقربَ إلى هبّة شعبية، أو تمرّد مجتمعي عفوي، أو انتفاضة ثورية المضمون، منه إلى ثورة منظّمة”، لكنه لا يتوقف عن تسميتها ثورة، وأحيانا ثورة الحرية، خلال التقدّم في صفحات الكتاب، ويعتبر أن بلوغ غايات التمرّد وطموحاته كانت “رهناً بنموه إلى ثورة، يتوفّر لها ما لا يتوفّر لتمرّد قد يغرق في العشوائية، كالقيادة الموحّدة، والبرامج، وخطط الصراع ووسائله، والشرعية الوطنية، والاعتراف الخارجي، وقابلية التصعيد شعبياً وسياسياً”، إلى جانب الحماية من الانحرافات والانزياحات المعادية لرهانات وأهداف الثورة، سواء كانت انزياحات مؤدلجة أو متمذهبة، كتلك التي ترتّبت أساساً على إطلاق سراح مقاتلي تنظيم القاعدة وجماعات السلفيّة الجهادية من سجون الأسد، وما أدّى إليه من تشكيل تنظيمات مذهبية مسلحة، رفضت مبدأي التمرّد والحراك الشعبي: الحرّيّة والسّلميّة من جهة، والقول بوحدة الشعب السوري من جهة أخرى”. وبالنظر إلى استهداف نظام الأسد النشطاء والثوار المدنيين، واستخدامه العنف المتزايد ضد المجتمع الأهلي والحاضنة الشعبية للتمرّد، حدث تحول مفصلي، عندما “أُخذ التمرّد إلى نقيض ما كان يتطلبه تحوله إلى ثورة”، حيث عمل النظام على تشتيت الحراك المدني، وإثارة تناقضاتٍ بين طرفيه المدني والأهلي، وساعدته في ذلك تنظيماتٌ ذات نهج مذهبي ازداد تعسكراً، بعدما أطلق نظام الأسد قادتها ورموزها من سجونه. وبالتوازي مع ذلك، اعتقد معظم من تصدّروا قيادات المعارضة أن تدخّلاً خارجياً سيحسم الصراع لصالح الشعب السوري، على غرار ما حصل في العراق وليبيا. وكان ذلك رهاناً خاطئاً، فيما أدّى العامل الخارجي الذي دخل إلى التمرّد الثوري حوّل سورية إلى ساحة صراعات خارجية لا علاقة لها بحراك السوريين الاحتجاجي الثوري، ولا دور لهم فيها ولا تأثير.
الفوضى الخلاقة
يعزو المؤلف ما حلّ بسورية وبثورة السوريين إلى مقولة أساسية، تشكّل الفرضية الأساسية للكتاب، وتتجسّد في تبنّي الولايات المتحدة خطة “الفوضى الخلاقة”، التي اجترحها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة، ولخصتها كوندوليزا رايس في العام 2005 بالقول: “عندما يصل مجتمع ما إلى أقصى درجات الفوضى المتمثّلة في العنف الهائل وإراقة الدّماء وإشاعة أكبر قدر من الخوف لدى الجماهير، فإنّه يصبح من الممكن بناؤه من جديد بهويّة جديدة تخدم مصالح الجميع”، ثم أعلنت عن بدء تطبيقها في العالم العربي، من أجل إعادة تشكيل الشرق الأوسط. وكان من سوء طالع الثورة السورية أنها جاءت في تلك المرحلة من تحوّل نهج وسياسات الولايات المتحدة، وخاصة خلال فترة حكم باراك أوباما، حيث إن كل ما اعترى الثورة من انتكاسات وفشل تتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية الأكبر عنه، إضافة إلى تلازم الأخذ بسياسات الفوضى الخلاقة مع تحوّل روسيا فلاديمير بوتين إلى القوة العسكرية لتحقيق أهدافها القومية على الصعيدين المحلي والدولي، وكان هذا التحوّل هو السبب في الرفض الروسي لثورة الحرية، وجعل الكرملين يرى فيها تقويضاً لـ”سورية الأسد”.
وتجسّد نهج الفوضى الخلّاقة في عدم سعي الإدارة الأميركية في عهد أوباما إلى إسقاط الأسد، متذرعة بعدم وجود بديل له، وبرعاية أمن ومصالح إسرائيل، لذلك قامت بمراقبة وضبط “الفوضى السورية”، بوصفها الأداة التي اعتمدتها لتلعب الدور الرئيس في تخريب الثورة، فرفضت تحول سورية إلى بديل ديمقراطي أو إسلامي، نظراً لما قد يمثلانه من تحدّ لإسرائيل ولنظم الخليج النفطية، لأن انتصار أحد هذين البديلين يهدد استقرارها. إضافة إلى أن إسرائيل لن تسمح بدورها بانتصار أحدهما، فهي تتمسّك بالنظام الأسدي، كونه يجنّبها مواجهة تحدّيات جديدة، لم يسبق لها أن تعاملت معها، فضلاً عن تدميره سورية، دولة ومجتمعاً، لذلك “تبنت إسرائيل خيار الفوضى الخلاقة الأميركي، الذي فكك سورية ودمر دولتها ومجتمعها باليد الأسدية”، التي كان لها الدور الأكبر في إدامة وإنجاح الفوضى الخلاقة. والأمر نفسه ينسحب على دول الخليج التي تريد فصل نظام الأسد عن النظام الإيراني، ولا تريد أن تنتصر الثورة، لأن بديليها سيطرحان عليها تحدّياتٍ غير مسبوقة تتصل بشرعيتها وبأوضاعها الداخلية. وبالتالي، شكل بقاء الأسدية ونظامها مصلحة استراتيجية لها ولإسرائيل وللولايات المتحدة، كما هو مصلحة استراتيجية أيضاً لروسيا بوتين ولنظام الملالي الإيراني وحزب الله وغيره من تنظيمات الارتزاق والإرهاب، وذلك بعدما بات الصراع في سورية عربياً إقليميا ودولياً، أُرغم الجميع فيه على الالتزام بما قرّره البيت الأبيض في خطة الفوضى الخلاقة.
ويوسّع ميشيل كيلو تناوله السياسات الأميركية حيال الثورة السورية، بإرجاع محدّداتها إلى اعتماد الإدارات الأميركية بدءاً من جورج دبليو بوش، خيار الفوضى الخلاقة كاستراتيجيّة مواجهة مع العالم الإسلامي بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، حيث اختارت الولايات المتحدة حيال العالم العربي “بدائل وسياسات تفتح باب كسرهم، وترجّحه على باب كسبهم”، على أن يبدأ كسر العرب من المشرق العربي. وترافق ذلك مع صعود اليمين، ممثلاً بالمحافظين الجدد، و”شروعه في حرب عالمية رابعة، معلنة وخفية، موجّهة ضدّ العالم الإسلاميّ والعرب، بحجّة الحرب على إرهابه الذي يهدّد العالم”، وأفضى ذلك إلى تدمير العراق، قبل إقامة شراكة فيه مع إيران التي تبنّت بدورها سياسات الفوضى الخلاقة، نظراً إلى أن هدفها هو تفكيك الدول العربية.
ومنذ بداية الثورة السورية، لم تعلن واشنطن دعمها الخيار الدّيمقراطيّ بديلا للأسديّة، واكتفت بإطلاق تصريحاتٍ كلاميّة ضدها، والاستفادة “من خيارات ومواقف الأسد وإيران وروسيا وبلدان الخليج وكلّ من يُساهم من مرتزقة في جعل الفوضى الخلاقة نتاجاً حتمياً لقمع تمرّد مجتمعي، ينضوي قمعه في المرحلة الأولى على خطة تفكيك دول المنطقة الأميركيّة، التي تُبقي على دولها العميقة بقدر ما تنخرط فيها وتضمن دعم إسرائيل لها. وراحت الولايات المتحدة تدير توازناً عسكرياً سياسياً يحول دون نجاح أي طرف في حسم الحرب، سواء بانتصار عسكري أم بحل سياسي”.
وبنت الولايات المتحدة سياساتها في سوريّة على استراتيجية إطالة أمد الصراع وتصعيده، واستجلاب قوى متناقضة في مصالحها وسياساتها وهوياتها إليه، ومنع أي طرفٍ من الانفراد بحسمه، قبل إنضاج الشّروط التي تتّفق وأهدافها بكسر العرب دولة بعد أخرى، لذلك كان فتح الصراع في سورية وعليها أمام تدخّلات الخارج عامّة، وإيران وروسيا خاصّة، أوّل ما فعلته إدارة الرئيس باراك أوباما.
وكشف اتفاق الرئيسين الأميركي أوباما والروسي بوتين بعد مجزرة الكيماوي، التي ارتكبها نظام الأسد في غوطة دمشق، طبيعة رهانات واشنطن واهتماماتها الحقيقيّة، حيث أظهر أن أولويّتها تتركّز على “تدويخ المعارضة بالفوضى الخلاقة، وعلى أمن إسرائيل”، حيث اقتضت الصفقة بينهما تسليم مخزون النظام من غاز السارين مقابل إفلاته من العقاب، وفي الوقت نفسه بقيت لديه أنواع أخرى من الغاز، سمح المجتمع الدولي باستعمالها ضد السوريين، كالكلور والخردل، الأمر الذي عنى السماح له بمواصلة مجازره بأسلحة لا تقل فتكاً عن السلاح الكيماوي. وشكلت صفقة الكيماوي خطوة إضافيّة على طريق تعزيز الحقل البنيوي الأميركي، وتوطيد وحدته مع البنية الأمنية الإسرائيلية، فيما اتّضح مع الحرب الأميركية على “داعش” أن “دعم الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي الأوجلاني لم يكن أقلّ من دعم إيران وروسيا الأسد، وذلك مع “الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الحرب مع التخلي عن أولويّة إسقاط الأسد ونظامه، وتسويغ موقفها بتدنّي أهمية المعركة ضدّه، بالمقارنة مع المعركة ضد داعش”، والتفاهم مع روسيا.
التدخل الروسي
يرى ميشيل كيلو أن الولايات المتحدة تركت جميع المتدخلين الإقليميين والدوليين يغزونها من دون أن تبدي أي اعتراض على أحد، لأسبابٍ تتعلق بخطتها في الفوضى الخلاقة، لذلك لم تعترض على “الغزو الرّوسيّ لسورية، والصحيح أنها أيّدته أو غضّت النظر عنه”. غير أن روسيا وقفت إلى جانب نظام الأسد منذ اليوم الأول للثورة، وقدّمت كل أنواع الدعم والإسناد له، بل ودافعت عنه في المحافل الدولية، لكنّ التدخل العسكري لصالحه عام 2015، جاء مدفوعاً بطموح بوتين بالعظمة الإمبراطورية، وإيثار استعادة سورية إلى الحضن الروسي، كما كانت من قبل إبّان فترة الاتحاد السوفييتي المندثر، وبانزعاجه الشديد من الخديعة التي أنزلتها به دول الغرب في ليبيا، ومقتل حليفه القذافي بعد إسقاط نظامه.
وكرّس التدخل الروسي القوي في الصراع في سورية وعليها، وما شهده الموقفان الدولي والأميركي من تحوّلات، نمط الحضور الذي اختارته موسكو في سورية، وسمح لها بممارسة سياساتٍ “وطّدت مواقعها كدولة غازية قررت الانتشار خارج حدودها، واعتبار خصوم الأسديّة أعداء مارست اقتدارها العسكريّ عليهم، وتحالفت مع إيران الخارجة على القانون والتي لم تقلع يومًا عن تقويض أمن وسلام المنطقة وشعوبها، مذ قامت جمهوريتها الإسلاميّة عام 1979، تكامل دورها مع دور واشنطن، وتفاعله بإيجابيّة مع نهج الفوضى الخلاقة”. لكن الولايات المتحدة وافقت على تفويض موسكو بحسم الصراع العسكري بالقوة، لصالحها، لكن روسيا فسّرته تفويضا بحسم المآلات النهائيّة لمجمل الصراع السوري، وربطت وجودها في سورية بالاستئثار بشؤونها، وبإقامة الأرضية الضرورية لحل يكون لقوتها العسكرية الدور الرئيس في تهيئته، وبانقلابها على القرارات الدوليّة، وتعطيل مجلس الأمن.
ويعتبر ميشيل كيلو أن تعاون روسيا مع تنظيمات الإرهاب المحلية، الأسدية، وتنظيماته غير السورية، أفضى إلى شرعنة نشوء شبكة إرهاب عابرة للدول، تضم عناصر من إيران والعراق ولبنان وأوزبكستان وباكستان وبنغلادش والشيشان وتونس والمغرب والجزائر ومصر والأردن والسعودية… إلخ، سيكون من الصعب تفكيكها حتى بعد الحل السياسي.
التدخل الإيراني
وبخصوص التدخل الإيراني في سورية، يرجع ميشيل كيلو إلى تبيان المكانة الخاصة التي تحتلها سورية في المحور الشيعي، بوصفها أول دولة عربية نجح النظام الإيراني في اختراق قيادتها وبناها السياسية والعسكرية مذهبياً، ودمجها في نظام أمن إقليمي الهوية، يتمحور حول إيران. و”عندما قامت الثورة السوريّة يوم 15 آذار (مارس) 2011، كانت تبعية النظام السوري لإيران قد بلغت حداً دفع الأخيرة إلى إرسال عناصر وضباط من الحرس الثوري إلى دمشق، قبل شهر من انفجار المجتمع”. لكن إيران تدين لروسيا بنجاحها في سورية، بما وضعته في خدمتها من تنظيمات شيعيّة، درّبتها إيران وسلّحتها وموّلتها، واخترقت مجتمعاتها بها، وأنجزت فيها مهمّات كان حرسها الثوري هو الذي سيتولاها، لو احتلها، أشهرها حزب الله اللبناني، و”ما يؤديه من وظائف هي من صميم مهام الحرس الثوري”.
وكان التدامج، بحامله الطائفي المذهبي العابر للسياسة، هو حاضنة مواقف إيران من الصراع السوري ونتائجه التي تتركّز على سحق الثّورة وإنزال هزيمة شاملة بها، لذلك اتّبع النظام الإيراني ومليشياته الطائفية في سورية، مثل النظام وأكثر، سياسات الأرض المحروقة والقتل والتهجير والتغيير الديموغرافي، وكان الهدف من “تهجير ملايين السنة من طرف النظام وإيران هو توطيد النظام الطائفي، والتشييع”.
غير أن التقاء روسيا وإيران على الانخراط في الحرب لإنقاذ الأسد ونظامه، جعل كلا منهما يتجاهل ما بينهما من خلافاتٍ وتبايناتٍ حول أهدافهما البعيدة، لذلك قامتا بتقسيم عملٍ يتولّى الروس فيه التخطيط والمهام القيادية والتسليح وشنّ الحرب الجوية، فيما يتولّى الإيرانيون الأعمال الأرضية وبعض التسليح والأعمال المخابراتية والدعويّة.
الدور الخليجي
ينطلق ميشيل كيلو في تناول دور بلدان الخليج في الصراع السوري من أنها تعاني مأزقاً ينتجه الفارق بين رغبتها في ردع إيران ومواجهتها ودحرها بأيدي السوريين وإبعادها عن الخليج، وبين الخطوط الحمراء التي وضعتها لنفسها، وتلك التي رسمتها الولايات المتحدة لها في الصراع، إلى جانب عجزها عن خوض صراع مفتوح ومباشر مع إيران، لذلك اتبعت سياسات عزّزت ما بين السوريين من تناقضاتٍ وخلافات، أبرز محطّاتها تدخل بعض دولها في تشكيل هيئات المعارضة السياسية، وإغراق الفصائل المتأسلمة المتعسكرة بالمال السياسي، ومساعدتها في إحباط محاولات توحيد قطاعي الثورة السياسي والعسكري.
ويعتبر المؤلف أن السوريين دافعوا عن أمن دول الخليج وسلامها بثورتهم، فيما لم تدافع دول الخليج عن أمن سورية وسلامها، أو عن أمنها وسلامها الخاص، وذلك بسبب ما اعتمدته من سياسات، وبالتالي “زرعت مواقفها ريحاً في سورية ما لبثت عاصفتها أن هبّت في اليمن بالتزامها بخطوط واشنطن الحمراء، وقبولها استراتيجية (الفوضى الخلاقة)”. وقد أوقعت تلك السياسات بلدان الخليج في مفارقة مأزقية، تجسّدت من جهة أولى في تقييد دعمها السوريين، على الرغم من أنه يعني فشلها في تحقيق هدفها الإيراني، والمحافظة على أمنها واستقرارها، كما تجسّد من جهة ثانية في “نشوء خطر جدّي عليها، يعود إلى دعم الثورة وردّات فعل إيران المحتملة عليها في الخارج، وأتباعها في الداخل، وخصوصا في البحرين والكويت”، لذلك يعتبر المؤلف أن نهج دول الخليج كان مجافياً لطبيعة ما يفترضه انتماؤه إلى مجال قومي تشاركه سورية عضويته، وهي روابط ليست برّانية بالنسبة إلى أي من أطرافه، ويطالب بمواجهة التدخل الإيراني بردٍّ “قومي”، بالنظر إلى ما يحمله من تهديد للوجود العربي.
التدخل التركي
ويستعرض ميشيل كيلو سياسات تركيا تجاه الحدث السوري، ويجد أنها مرّت بمراحل متناقضة، اتّسمت في بعضها بالتحفّظ، وبعضها الآخر باندفاع بلغ حدود المخاطرة، حيث طالبت القيادة التركية الأسد بإجراء إصلاحاتٍ، لكنه رفضها، ثم حدثت القطيعة معه، واستقطبت تركيا ملايين اللاجئين، لكنها قامت أيضاً بعمليات عسكرية في الشمال السوري، بذريعة حماية أمنها وحدودها من التنظيمات الكردية التي تصنّفها إرهابية.
ولم تتعارض الخطوط الحمراء الأميركية، وقبولها استراتيجية الفوضى الخلاقة، مع فتح حدود تركيا أمام القادمين من كل أنحاء العالم للمشاركة في الحرب السورية، ثم أحدثت انعطافة في سياساتها، فأخذت بالمراهنة على روسيا من أجل نيل حصّتها في سورية، وباتت تطلب دعم موقفها من المسألة الكرديّة، كمسألة أمن قومي تتوقف عليها وحدة دولتها ومجتمعها.
ومع التنسيق مع روسيا وإيران، باتت تركيا في حالة من “التبعيّة الاستراتيجيّة” لروسيا انعكست على علاقات تركيا بالفصائل والائتلاف السوري المعارض، أي بقطاعي الثورة العسكريّ والسياسيّ، وبنمط الحلول المطلوبة للصراع وهوية من سيتولّون القيام به، ومثّل ذلك انقلاباً في سياسة تركيا التي وجدت نفسها محكومة بظروف وبوتائر متزايدة متابعة مصالحها القوميّة.
والحاصل أن ميشيل كيلو كتب كتابه من موقع المناضل المنخرط في قضية بلده وثورته، فلم يخف غضبه على سياسات الدول الخائضة في الدم السوري، وجمع فيه ما بين التناول الحدثي (والوقائعي) والتحليل السياسي، مع تبيان موقفه المنحاز بشدة إلى ثورة السوريين، وكرهه الاصطفافات مع نظام الإجرام الأسدي، والممارسات الطائفية والمذهبية لنظام الملالي الإيراني، وسياسات بوتين العدوانية والمتغطرسة، فضلاً عن السخط على استراتيجية الفوضى الخلاقة التي اتبعتها الولايات المتحدة، حسب رأيه، في التعامل مع الصراع في سورية وعليها.
المصدر: العربي الجديد