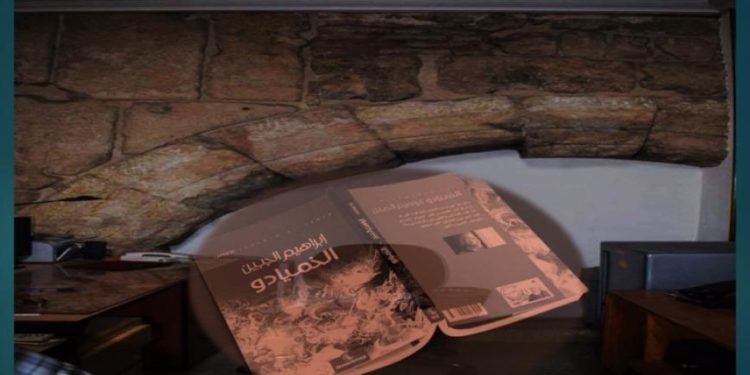أحمد العربي
إبراهيم الجبين روائي وكاتب سوري متعدد المناشط الثقافية، قرأت له عدداً من رواياته المنشورة سابقاً مثل “عين الشرق” و”يوميات يهودي من دمشق”، مع كتابه التحقيقي الضخم عن فخري البارودي “الرحلة الأوروبية”، واليوم أجد نفسي بمواجهة روايته الجديدة الصادرة مطلع هذا العام في إسطنبول عن دار “فارابي كتاب”.
الرواية التي تعتمد أسلوب المتكلم، تبدو كأنها أقرب لسيرة ذاتية كتبها الجبين، مثلما يفعل في أعماله السابقة، وهو أحد شخوصها وأبطالها.
للرواية مسارات متعددة متوازية وفي بعض الأحيان متراكبة متداخلة في الزمان وفي المكان وفي ذات إبراهيم الجبين الذي يسترجع في هذه الرواية كثيراً مما عاشه في حياته، مركّزاً على دمشق هواه الصوفي الأول، وعلى الثورة السورية التي يراها تعبيراً عن انعتاق السوريين وتمثيل انتصارهم الإنساني لكرامتهم وحريتهم وتوقعهم للعدالة والحياة الأفضل، منذ اللحظة الأولى للثورة بغض النظر عن المسارات التي سارت بها بعد ذلك. حيث لعبت بها السياسة والمصالح والتدخلات الإقليمية والدولية، ناهيك عن أزمة السوريين أنفسهم الذين وجدوا أمام إنسانيتهم وجهاً لوجه مع مسؤوليتهم الكاملة عما فعلوه ويفعلونه، وهم بعد لم يكسروا قيود العبودية ولم يمتلكوا ناصية أنفسهم مجتمعا ونخبة، لقيادة مسيرة الثورة كما يجب
المسار الأول للرواية يبدأ من اجتماع يضم الراوي وثلاثة خبراء بينهم سيدة، عكفوا على دراسة أحد بيوت دمشق القديمة الذي يقبع في سوق البزورية ويعرفه الناس باسم “بيت العقاد” حيث تظهر آثار معمارية لمدرج روماني بعضه ظاهر ويعتقد الجبين أن معظمه ما زال موجوداً تحت الأرض. يتحول ذلك الاجتماع إلى ورشة عمل يمتد الحديث فيها إلى دمشق وتاريخها منذ آلاف السنين وصولاً إلى زمن الثورة. دمشق التي كانت في عصور كثيرة قلب العالم، والتي ما يزال كثيرون يرونها كذلك رغم كل آلامها وأحزانها. دمشق التي تتالى عليها أزمنة وعهود ودول كثيرة. وفي كل عصر كانت تحتضن أثرا جديدا يؤكد مركزيتها وأهميتها. كان الفريق يبحث ويتبادل الرأي والمعلومات، وتزداد دمشق حضورا كجوهرة تمتص الضوء وتصدّر المزيد من الألغاز. دمشق وبلاد الشام التي أنجبت قادة وحكاماً رومانيين، وكانت حاضرة الأمويين الذين فرشوا ظلهم على العالم، ليصلوا الى الأندلس حاملين معهم دينهم ولغتهم و صنعوا مجدهم لمئات السنين و يؤثروا في التأسيس للحضارة الغربية الحالية بالفكر والعلوم، دمشق التي راودها عن نفسها الفاتحون والمحتلون والمرتزقة عبر العصور، لكنها هضمتهم كلهم وجعلتهم جزءاً من حكايتها الخالدة.
يستمر البحث والتقصي من قبل الفريق في دار العقاد عما يسميه الجبين “كوليسيوم” دمشقي، يفترض وجوده في طبقة ما تحت الأرض أو وراء جدار في تلك الدار العريقة، ليصل التنقيب اإلى حيز يكشف ذلك المكان. ليفاجأ القارئ بأن ما يختبئ خلف الجدار في المكان المهجور، ليس الآثار وحدها، بل بشر منسيون يعيشون فيه من عصور بعيدة، طوروا القدرة على العيش في جوف الأرض من إمكانات الطبيعة ومائها الجاري ونباتاتها المتعرشة على الجدران، هؤلاء لا يعتمدون اللغة للتواصل في ما بينهم رغم معرفتهم بها وتداولها بينهم كتابة وحرفاً، بل بالإشارة المتوارثة عبر أجيال كعلم في التخاطب يتناولون فيها كل شيء في حياتهم وحتى التعبير عن معتقداتهم وإيمانهم.
سيكون للكشف أثر سحري على الجميع. فهؤلاء المزروعون في جوف دمشق هم بقايا بشر كانوا قد اختبؤوا من ظلم ظالم ومن بطش حاكم، وعاشوا حياتهم السرمدية تلك. خلقوا “الخميادو” التي هي لغة الاتصال بينهم قبل أو بعد أن يخلقها عرب الأندلس خوفاً ممن حظروا عليهم اللغة العربية، اعتمدوا لغة سريّة بينهم لمواجهة التطهير الذي فرضه الإسبان بحق العرب المسلمين في أواخر عهدهم في تلك الأرض. لغة تواجه الانقراض والإلغاء في كل زمان ومكان. وقد أتى هذا العالم الغرائبي المعبر رمزيا عن حال البشر في دمشق رائعاً في سياق الرواية.
ستقود الخرائط التي ضمّنها الجبين كتابه هذا فريق الباحثين إلى مواقع أخرى في المشرق، من بينها الجولان السوري المحتل، تدل على تفوق فكري وعلمي عظيم موغل في القدم قام به أسلافنا الذين عاشوا في بلاد الشام منذ آلاف السنين.
أما المسار الثاني للرواية الذي هو لبّها وجوهرها. فهو قصة سوريا كما عاش فيها الجبين قبل الثورة وبعدها وحتى حضوره كقادم إليها في المستقبل بعد زمن طويل، برفقة البروفيسور دورينغ وآن والرفاعي.
إبراهيم الجبين ابن الجزيرة السورية القادم إلى دمشق الشارب من مائها والمتشرّب وجودها الصوفي في وجدانه، بحيث أصبحت عشقه ومبعث الإلهام في وجدانه. عاش في دمشق التي لم يغب عن سمائها ظلام النظام المستبد وظلمه، أخبرنا في روايته عن التفاوت الاجتماعي وعن المظالم و الاستبداد وهيمنة النظام ببنيته الطائفية على الجيش والأمن وأهم مفاصل الدولة. وكيف كان السوريون عبر عقود يتجرعون الهوان والمظالم، ولم يستطيعوا أن يغيروا من الحال شيئا، رغم أن الشعب أفرز النخبة السياسية والمثقفة التي واجهت النظام وكابدت السجن والاعتقال والقتل. حصل ذلك في عصر الأسد الأب وكذلك الابن الذي ادعى في أول حكمه أنه يبغي الإصلاح والتغيير، لكنه لم يصدق في وعوده وعادت سورية مملكة الخوف والصمت والظلم. إلى أن جاء ربيع سوريا الأكبر في عام 2011 وخرج السوريون منتفضين على ظالمهم بمظاهرات سلمية مطالبة بالحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية. لكن النظام لم يقبل أبدا أن يقدم أي تنازل وعمل على شيطنة الثورة، واتهامها بالطائفية والإرهاب والعمالة للصهيونية والغرب. وضربها بيد من حديد، أدت بعد سنوات لمئات آلاف الشهداء والمصابين وملايين المشردين وتدمير أكثر من نصف البنية التحية في بلدات سوريا ومدنها.
كان الجبين منذ البداية منغمساً في الثورة كفعل حياة يومي، ولم يكن بعيداً عن أجواء الثقافة والإعلام، كان له حضوره و موقفه الجذري من الاستبداد والمظالم جمرة تحت الرماد. عندما بدأت الثورة، أصبح مشاركاً في نشاطها الإعلامي والتنويري، بأسماء سرية كأغلب السوريين، تحجبهم عن عين ويد النظام القاتل. كما تواصل مع كثير من أركان النظام ممن كان يعرفهم سابقاً ليصغي إليهم ويعرف كيف يفكرون، وتداول معهم الرأي حول ما يحصل وما هي المخارج من المأزق الذي وجد الحُكم فيه نفسه.
عرف عن كثب أن كل من لم يقبل خيار رأس النظام وداعميه الروس والإيرانيين سوف يتم استبعاده عن مركز القرار، سواء بالعزل أو بالاغتيال، مثلما حصل في تفجير خلية الأزمة الشهير، حين تم التخلص من صهر الرئيس والرجل القوي آصف شوكت.
استمر الجبين، مثل كثيرين، في الداخل السوري يقوم بما كان يرى أنه فعل مؤثر، إلى أن خرج من سوريا مهاجراً رغما عنه الى أقصى الشمال في الدنمارك ثم إلى الجنوب في دبي، وأخيراً إلى الغرب في ألمانيا ليبدأ حياة جديدة.كما قد يعتقد البعض، لكنه مع ذلك بقي في دمشق.
أما المسار الثالث الذي يظهر في الرواية على شكل حاشية تذكّر بالكتب والمخطوطات القديمة بخط أصغر وفي منسدلات جانبية قرب الصفحات، فهو مواصلة حثيثة لبحث الجبين عن ضباط الاستخبارات النازيين الذين هربوا من ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية واستقروا في دمشق. هؤلاء الضباط الذين كانت لهم أدوار رهيبة في محارق اليهود في معسكرات الاعتقال النازية، وأدوار أخرى في شبكة القتل النازية. هؤلاء الضباط الذين تخفوا وظهروا بأسماء مستعارة ولاذوا بدمشق وبقية العواصم العربية، سيكون لهم دور أساسي وجوهري في بناء الأنظمة الاستخبارية والأمنية في سوريا وعدد من الدول العربية. بعد أن باعوا خبراتهم وولاءهم للأنظمة العربية الاستبدادية الوليدة التي استباحت الشعوب وهدرت دمائها وكرامتها و جعلت الناس عبيداً بالقوة لعقود طويلة.
في “الخميادو” نحن أمام عمل روائي مختلف عن سياق الروايات السورية التي نعرفها، فيه الأدب وفيه البعد الصحافي والبحثي والتاريخي، كتبه إبراهيم الجبين وأراد أن يكون أميناً فيه مع ذاته الإنسانية ومع دمشق شغفه الكبير، وسوريا وشعبها وثورتها العظيمة، قدّم شهادته لنفسه وللعالم. وكان وفيا لما آمن به. وبقدر ما كان الخيال فاتناً في هذه الرواية، كانت الوثيقة الحقيقية والقصص الإنسانية والأشخاص الحقيقيون الذين عرفهم السوريون عن بعد أكثر فتنة وجذباً.
المصدر: تلفزيون سوريا