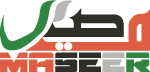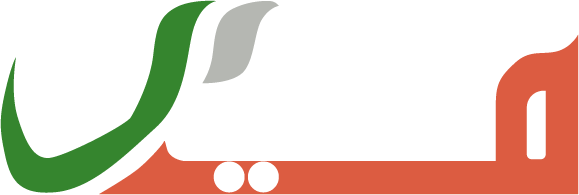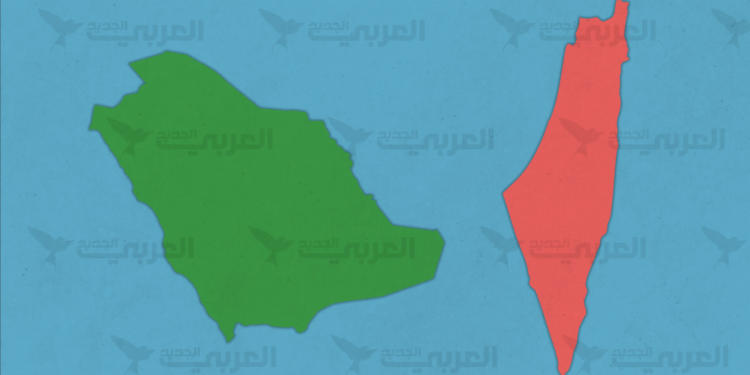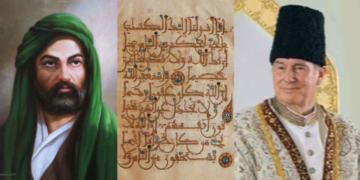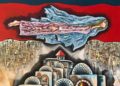أمجد أحمد جبريل
تضمّن مقال خالد الحروب “السعودية: القيادة الإقليمية بديلاً من التطبيع المُدمِّر” (“العربي الجديد”، 10/2/2025)، رسالتَين مهمَّتَين تستحقّان مناقشتهما عن انتفاء الحاجة السعودية (والعربية) إلى التطبيع مع إسرائيل، بعد التطوّرات في سورية ولبنان، وثانياً تصاعد رغبات “لوبيات اليمين المتعصّب في الكونغرس الأميركي والكنيست الإسرائيلي في تحييد السعودية في المدى القصير، وإحباط أي تطلّع سعودي إلى بناء كيان إقليمي متماسك على المدى البعيد. وانكشاف أهداف الطرفَين في توريط الرياض، خصوصاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستطع كبت رغباته الدفينة وتعصّبه، عندما طالب السعودية أخيراً، باستقبال الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية في أراضيها”.
وعلى الرغم من وجود “فرصة” أمام العرب، خصوصاً السعودية ومصر، لرفض ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولا سيّما في تهجير أهالي قطاع غزّة، يتوقف هذا المقال مع خمس ملاحظات تفصيلية تحاور (ولا تنقض بالضرورة) حجج الكاتب واستنتاجاته القيّمة. أولاً، على الرغم من أن انحسار نفوذ طهران في سورية ولبنان ينهي بالفعل أيّ حاجة سعودية للتطبيع مع إسرائيل، فإن مساحة الحركة السعودية لشدّ أطراف المنطقة العربية ليست مطلقة ولا مفتوحة، بل إن مجرّد الرهان على إحياء “الإطار العربي” يبدو صعباً من دون توفر ثلاثة شروط متداخلة؛ أولها تجاوز حالة العجز الرسمي العربي (أو بالأحرى “التظاهر بالعجز”)، كما تجلّت على مدار شهور حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة. وثانيها بلورة مقاربة عربية جديدة لإدارة الصراع مع إسرائيل، التي عادت سيرتها الإرهابية/ الاستئصالية الأولى، بعد تحوّل الجيش الصهيوني إلى سلوك مليشيات/ عصابات مسلّحة لا تلتزم بأيّ معاير قانونية دولية (احترام قوانين الحرب، والقانون الدولي الإنساني)، ناهيك عن الأسس الأخلاقية والانضباط العسكري، ما يعني أن الحكومات الإسرائيلية أزالت مساحيق خطاب التسوية السياسية (1993 – 1996) بعد انتهاء وظيفته، ولم تعد مستعدّةً للاعتراف بأيّ حقوق فلسطينية، مهما بلغ تواضعها. وثالثها إعادة قضية فلسطين إلى صدارة الأولويات العربية، ما يقتضي تفاهمات عربية (وإقليمية ودولية) بشأن سياسات عملية سريعة للتصدّي للتغوّل الإسرائيلي.
تتعلّق الملاحظة الثانية باختلافي الشديد مع دعوة الكاتب إلى “تبلور خطاب سعودي وعربي جماعي حول المبادرة العربية للسلام. ورغم أنها تمثل الحدّ الأدنى للحقوق الفلسطينية، فإنها تفرض موقفاً دبلوماسياً قوياً وجماعياً، ولا يجب التفريط فيه أو التراجع عنه”. والحق أن دراسين عربا يقولون بأهمية البحث عن استراتيجية عربية بديلة، بعد وضوح إخفاق المبادرة العربية للسلام المطروحة منذ 23 عاماً تقريباً (كونها ولدت ميتةً أصلاً، وجاءت خاليةً من أيّ أدوات ضغط أو أنياب تنقلها إلى مستوى الاستراتيجية الفعّالة، ناهيك عن عدم قابلية المبادرة للتنفيذ إسرائيلياً في غياب أيّ قبول مجتمعي/ سياسي إسرائيلي لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، مع الصعود المطرد لتيّارات اليمين الإسرائيلي المتطرّف، بالإضافة إلى تجاوز دول اتفاقات أبراهام عام 2020 منطق الربط بين التطبيع والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما تنصّ المبادرة إيّاها).
وقائع عملية التسوية مع إسرائيل، منذ اتفاقية كامب ديفيد (17/9/1978)، تؤكّد أن ثمّة تراجعاً عربياً مطرداً في الصراع العربي الإسرائيلي إجمالاً، وقضية فلسطين خصوصاً
تتعلّق الملاحظة الثالثة بتأكيد ما جاء به الحروب حول “الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وقضية فلسطين بوصفهما بوابة النفوذ الإقليمي، في الماضي والحاضر”. بيد أن وقائع عملية التسوية مع إسرائيل، منذ اتفاقية كامب ديفيد (17/9/1978)، تؤكّد أن ثمّة تراجعاً عربياً مطرداً في الصراع العربي الإسرائيلي إجمالاً، وقضية فلسطين خصوصاً، التي لم تعد تشكّل مدخلاً رئيساً في العلاقات العربية الأميركية (كما حدث استثنائياً إبّان حرب 1973، ثمّ الحظر النفطي العربي على أميركا والدول المساندة لإسرائيل). ما يعني أن “احتمال التقاط القضية الفلسطينية فعلياً في هذه اللحظة الفارقة” يبدو محدوداً جدّاً، بسبب عوامل الضعف الهيكلية التي اعترت الإطار العربي، نتيجة تداعيات التسوية والتطبيع على اختراق هذا الإطار وتحكّم الضغوط الأميركية الإسرائيلية به، في مقابل الإهمال العربي بالانفتاح على قوى المقاومة الفلسطينية، التي تواجه خيارات الاضطرار والضرورة بسبب حصارها/ عزلها عربياً، بالتوازي مع نجاح إيران في توظيفها ضمن معادلاتها الصراعية مع واشنطن وتلّ أبيب، إضافة إلى قدرة أنقرة على تعديل/ تكييف مواقفها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، التي لا تتعارض بالضرورة مع دعم حلّ قضية فلسطين على أساس حلّ الدولتَين وقرارات الشرعية الدولية عموماً.
تتعلّق الملاحظة الرابعة بتأكيد وجود هامش مناورة أمام الرياض لرفض التطبيع مع إسرائيل، مع إمكانية الحصول على المساعدة في بناء مفاعلات طاقة نووية سلمية (من دول أخرى غير الولايات المتحدة، سواء من أوروبا أو الصين، في ظلّ توقّعات بأن تصبح بكّين عاصمة العالم والقوة العظمى الأولى فيه رغماً عن واشنطن وحليفاتها بحلول عام 2049).
غياب استراتيجية عربية متكاملة لإدارة الصراع مع إسرائيل، والتخلّي عن فلسطين بوصفها “قضيةً محوريةً” للعرب، والانشغال بقضايا مصطنعة من شأنه تعميق “فقدان البوصلة العربية”
تتعلّق الملاحظة الخامسة بالاتفاق مع الكاتب في أن “ترامب ليس قدراً سماوياً، على العرب الخضوع له والاستماع لتعليماته وتشكيل الكرة الأرضية والسياسة الدولية والإقليمية تبعاً لنزواته”؛ إذ يمكن شراء الوقت وتقطيعه ريثما ينصرف بعد أربع سنوات، خصوصاً بعد تصريحاته التي تطالب بضمّ كندا، وقناة بنما، وغرينلاند، والسيطرة على غزّة، وتسوية أزمة أوكرانيا عبر لقاءات أميركية روسية مباشرة، والتي أثارت موجةً من الرفض حتى من أقرب حلفاء واشنطن (مثل ألمانيا وفرنسا).
تتعلّق الملاحظة السادسة بالاختلاف مع الحروب في وجود “فرصة كبيرة للسعودية كي تقود العرب والإقليم”؛ إذ يبقى مهمّاً في رأيي المتواضع إبراز تحدّيات انتشار “الوظيفة القيادية” في إقليم الشرق الأوسط، وبعبارة أخرى، لا تستطيع أيٌّ من الدول الأربع الإقليمية الكبيرة (تركيا وإيران والسعودية ومصر)، أن تنهض منفردةً بقيادة المنطقة، أخذاً في الحسبان احتمال تصاعد ضغوط واشنطن وتحكّم “الذهنية الترامبية” التجارية، ومنطق الصفقات التي تنكر القانون الدولي وحقوق الشعوب ومصالح حلفاء واشنطن الدوليين والإقليميين.
واستطراداً في الإجابة عن سؤال العنوان: هل حانت لحظة السعودية وفلسطين؟، يمكن القول: نعم، ولكن”، بشرط استكمال الرياض والقاهرة وأنقرة وطهران خطوات وسياسات جوهرية تعيد قضية فلسطين قضيةً محوريةً للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، على نحو يضع قضية فلسطين وهُويَّتها وحقوق شعبها في قلب العلاقات الدولية للإقليم (أي تفاعلاتها الخارجية)، ما يتطلّب بالضرورة “اتفاقاً إقليمياً صارماً” على عزل دولة الاحتلال ومعاقبتها، وإغلاق نوافذ التطبيع كلّها، والخروج (ولو تدريجياً) من اتفاقات السلام، وفي رأسها اتفاق كامب ديفيد، الذي أضاف خمسة عقود لعمر إسرائيل الافتراضي؛ إذ شكّلت التسوية والتطبيع أداتَين أساسيتَين في الاستراتيجية الأميركية للهيمنة على الإقليم، والعمل على إدماج حليفها الإسرائيلي في المنطقة، من موقع قيادي، بمساعدة أغلب النظم العربية، وعلى حساب مصالح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية دائماً.
“لحظة السعودية وفلسطين” مشروطة باستكمال الرياض والقاهرة وأنقرة وطهران سياسات جوهرية تعيد قضية فلسطين قضيةً محوريةً
الإقليم في ظلّ إدارة ترامب الثانية سيشهد تحدّياً وجودياً كلّما فشل ترامب في إنقاذ حليفه الإسرائيلي، من تصاعد مأزقه الاستراتيجي مع الشعوب العربية، خصوصاً الحواضن الاجتماعية والشعبية لقوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بالتوازي مع ارتباك الرؤية الأميركية وغياب الاستراتيجية الكُبرى عن سياسات واشنطن، بسبب تداعيات النزعة “الترامبية الانعزالية”، خصوصاً العداء للمؤسّسات الدولية، وبروز أدوار الرئيس والنخب العقارية المحيطة به على حساب أدوار المؤسّسات الأميركية المستقرّة (فكرة تهجير أهالي غزّة نموذجاً)، ما قد يُفضي في المحصّلة إلى تآكل النفوذ الأميركي في إقليم الشرق الأوسط، بسبب بلوغ التعقيدات في المنطقة مستويات غير مسبوقة، مع احتمال خروج الأمور عن السيطرة، وبروز تيّارات راديكالية (جهادية، أو حتى فوضوية عنفية).
يبقى التأكيد على أمرَين؛ أحدهما تصاعد الصراعات الإقليمية نتيجة السياسات والضغوط الأميركية/ الإسرائيلية، مع احتمال فشل واشنطن في ضبط مستوى الصراع الإسرائيلي الإيراني، على نحو ربّما يأخذ الإقليم بأسره إلى حلقات من التصعيد والفوضى والأزمات الاستراتيجية، ما قد يؤدّي في المحصلة إلى إفلات الإقليم برمّته من الهيمنة الأميركية على نحو يؤكّد أن إسرائيل تحوّلت “عبئاً استراتيجياً” على واشنطن، خصوصاً في التعامل الأميركي مع الدول العربية (ولا سيما مصر والأردن والسعودية، وأيضاً مع إيران)، وهذا يعني إجمالاً أن العودة الأميركية الإسرائيلية إلى طرح حلول التهجير وتصفية قضية فلسطين والتصعيد العسكري المحتمل ضدّ طهران، هي مقدّمات لاحتمال دخول المنطقة سيناريو من “الفوضى الإقليمية الشاملة”، بسبب رضوخ واشنطن لأحلام تيّار اليمين الإسرائيلي غير العقلانية. والآخر أن غياب استراتيجية عربية متكاملة لإدارة الصراع مع إسرائيل، والتخلّي عن فلسطين بوصفها “قضيةً محوريةً” للعرب، والانشغال بقضايا مصطنعة (مثل مكافحة الإرهاب والتصدّي للخطر الإيراني)، من شأنه تعميق “فقدان البوصلة العربية”، بالتوازي مع تمكين العوامل الخارجية، ولا سيّما الصراع الأميركي/ الإسرائيلي مع إيران.
المصدر: العربي الجديد