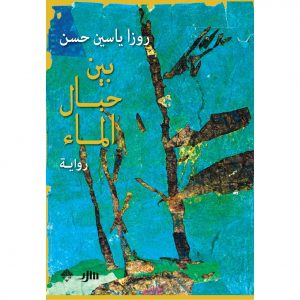علي الكردي
تطرح رواية الكاتبة السورية روزا ياسين حسن الجديدة (بين حبال الماء) إشكالية الكتابة حول الثورة السورية، والزاوية الفنية التي يمكن من خلالها مقاربة هذا الحدث المزلزل؛ إذ من الطبيعي أن يشعر أي كاتب سوري بأن من واجبه مقاربة هذا الحدث، بأبعاده المركبة على المستويات كافة، ولا سيما أن الفاجعة التراجيدية لأحداث الثورة السورية ما برحت تفاجئ بانعطافاتها الحادّة، وكثافتها ليس الكتّاب الروائيين فحسب، بل كل المشتغلين بحقول الإبداع، والعلوم الاجتماعية والسياسية…. لكن السؤال: هل يكفي شعور الكاتب بالواجب أو المسؤولية تجاه ما يجري، لإنجاز عمل روائي يهز روح القارئ ووجدانه؟!
ربما يحار أي كاتب -في الحقيقة- من أين يبدأ وكيف له أن يلتقط أو يختار الشكل الفني والجمالي المناسب الذي سيبني على أساسه عمارته الروائية. هذا أمر بدهي وعام، فكيف إذا كان موضوع الرواية حدثًا بمستوى تعقيد الثورة السورية؟!
لا شك أن فن الرواية يمنح الكاتب فضاءً واسعًا للتحليق والتخييل، وإمكانية المزج بين الواقع والخيال وتوظيف الأحلام والاستيهامات والتداعي الحر واستحضار الذاكرة وتداخل الأزمنة وتعدّد الأمكنة، إلى آخر ما هنالك من تفاصيل تغني النص وتجعله نابضًا بالحياة… لكن ثمة إشكالية ما تبرز في هذا السياق؛ تتعيّن في مدى قدرة الكاتب أو الكاتبة على تحقيق شرط الصدق الفني والإقناع، النابع أساسًا من مدى صدقه في الواقع، ومدى التحامه روحيًا ونفسيًا وفكريًا مع موضوعه.
دعونا -كي لا نقع في التعميم- نقيّم على ضوء ما سبق، رواية روزا ياسين حسن (بين حبال الماء)، كي نعرف الكاتبة أهي مسكونة بالفعل بهواجس الثورة السورية، وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية المعقدة، أم أنها كتبت ما كتبت تحت ضغط الواجب، أو ضرورة أن تدلي بدلوها تجاه هذا الحدث الرائج هذه الأيام؟!
تتلخص فكرة الرواية، بتتبع أحلام شاب سوري عشق السينما منذ طفولته، بتأثير جدّه الذي احتضنه بعد وفاة والديه بحادث سيارة مؤلم. يطمح الشاب إلى أن يصبح مخرجًا سينمائيًا، لذلك يسافر إلى دبيّ، كي يشتغل ويجمع بعض المال من أجل السفر إلى كوبا ودراسة السينما. يعاني في البداية من عمله الشاق في مطعم “ماكدونالدز”، ويسكن في غرفة معتمة بلا نوافذ هي أشبه بجحر، نافذته الوحيدة على العالم كانت شاشة كمبيوتره الزرقاء التي يشاهد من خلالها الأفلام. بعد مشادّة له مع أحد الزبائن، يقرّر ترك العمل. ينقذه من العوز والبطالة صديق سوري تعرّف إليه أثناء عمله في المطعم، ومن خلاله تعرّف إلى صديق آخر هو رجل أعمال سوري، له شبكة علاقات واسعة بعالم المال والأعمال. دبّر له وظيفة في شركة “نوكيا” للاتصالات. ينجح الشاب في عمله الجديد ويتدرّج وظيفيًا إلى أن يصبح أصغر مدير إقليمي للشركة. يسافر ويعقد الصفقات الرابحة. الوجه الآخر للمسألة أنه لم يغرق فقط بعالم المال والأعمال، بل انغمس أيضًا مع صديقيه بعالم الجنس والمخدرات وعلب الليل، وراح يتماهى مع ما كان يشاهده من أفلام عن تلك العوالم. إلى درجة كاد معها ينسى حلمه بدراسة السينما، وتحقيق أفلامه المتخيلة.
من حق الكاتبة بطبيعة الحال اختيار الزاوية الفنية التي تلج من خلالها إلى موضوع روايتها، واختيار روزا لتقنية الدمج بين مشاهد وحوارات من أفلام سينمائية مختارة، تتناسب مع استيهامات بطل روايتها، المنغمس بعالم الجنس والمخدرات والملاهي الليلية، وسطوة المال… هو تقنية جديدة تُحسب لها، وهذه مسألة تحتاج بالتأكيد إلى معرفة بالسينما، ومتابعة حثيثة لأفلام عالمية لها بصماتها، وقد أجادت الكاتبة في عملية التوليف بين تلك الأفلام، وبين حالات الشخصية وتحولاتها النفسية، وكان من الممكن -لو أنها استمرت في هذا السياق- أن تنتج رواية مكتملة العناصر، لكن أن تقحم إقحامًا أحداث الثورة السورية في الربع الأخير من الرواية، فهو أمر غير مبرّر منطقيًا، أو فنيًا. إذ يصحو ضمير الشخصية بشكل مفاجئ بعد موجة اكتئاب انتابته، بسبب انهيار علاقته مع عاهرة أحبها وسيطرت على روحه، إضافةً إلى موت أحد صديقيه وجدّه اللذين أصبحا ملاكين حارسين له في أحلامه. بعد شهرين من الانقطاع عن العمل، وبضغط من صديقه الآخر، وكي لا يخسر عمله ومصدر رزقه يذهب إلى الشركة، ويكلّف بالسفر إلى طوكيو لعقد صفقة كبرى من الممكن أن تعود عليه بالملايين، لكنه يُفشل بإرادته تلك الصفقة، ويقرّر القطيعة مع عالم المال، والتطهر من أدرانه. تكلفه المسألة طرده من الشركة. على نحو مباغت يعود إليه شغفه بالسينما، ويقرّر أن يعود إلى بلده سورية التي اندلعت فيها الثورة؛ إذ يرى أن ثمة أفلامًا يمكن له تحقيقها هناك، وبالتالي إحياء حلمه القديم المنسي. يشتري كاميرا ومستلزماتها، بما فيها “هارد” كي يخزن مادته المصوّرة، ويجري اتصالًا مع صديق قديم من أيام الدراسة، كي يؤمن له الدخول إلى مناطق المعارضة، وعلى الرغم من تلميح الكاتبة إلى عدم قناعته بالعنف واستخدام السلاح، واختلاف نظرته للأحداث عن نظرة المقاتلين، ولا سيّما مع تبدّل مرجعياتهم وأشكالهم، حيث تزداد أعداد من يرخون الذقون ويحلقون الشارب مع تطور الأحداث، فإنه لا يفصح أمامهم عن حقيقة أفكاره، ولا يكشف هويته الطائفية المختلفة، بل يتماهى معهم كي يحمي نفسه. ظل هاجسه الأساس هو التصوير من قلب الحدث، وجمع مادة مصوّرة، كي يبني عليها لاحقًا مشروع فيلمه، أو أفلامه التي لم يقرّر بعد هل ستكون أفلامًا وثائقية، أم درامية، أم يمكن له الدمج بين الجنسين.
استخدمت الكاتبة تقنية الراوي العليم، الذي يتخفى خلف الشخصيات، ويعرف تحولاتها ومآلات أحداثها، فكل شيء مخطط له بشكل مسبق، لذلك تتنقل الشخصية بين مناطق المعارضة من الغوطة بدايةً، إلى حمص ومن ثم حلب وريف إدلب دون أن نعرف كيف تنقلت، وتأتي لحظة تتعرض فيها مجموعته إلى قصف مباشر، فتصاب الشخصية بجروح في حين يستشهد صديقها.. بعد أن يتعافى، يبحث عن الكاميرا وعدة التصوير ويجدها ما زالت في مكانها. يعرض عليه مهرّب نقله إلى تركيا، وتتوالى على الطريق المخاطر من حواجز الجهاديين، ولا سيما أن بين المجموعة شابين منشقّين عن جيش النظام. ينبهما المهرب إلى ضرورة إتلاف هويتهما، ولأنه يشك بهويته الطائفية المختلفة ينبهه –أيضًا- إلى ضرورة التخلص من وثائقه. في آخر حاجز يفصلهم عن الحدود التركية، يُعتقل هو والشابان ورجل ستيني. يتعرّض الأخير لتعذيب شديد. بعد عشرة أيام يُطلق سراحهم، وتبدأ رحلة جديدة محفوفة بالمخاطر لاجتياز الحدود التركية، ومن ثم عبر البحر إلى اليونان، تتخللها عدة أحداث، ولا تكف الكاتبة عن استحضار بعض الأفلام، ودمجها مع تداعيات بطل الرواية الذي ينجو من الغرق بأعجوبة، بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم، حيث يفقد الكاميرا و”الهارد”، وبالتالي يخسر حلمه، ويشعر أنه مجرد قاتل تخلى عن إنقاذ امرأة ورضيعتها حتى لا يفقد حقيبة الكاميرا، مع أن المرأة تشبثت به وكادت تغرقه. في لحظة عبث وجنون يذهب إلى غابة قريبة من المكان الذي احتُجزوا فيه، وعينه على شجرة كبيرة يتسلّقها، حيث قرّر الانتحار. يلف شريط أسود متين أحضره معه من مبنى اللاجئين حول غصن الشجرة، ويشكّل ربطة تتسع لإدخال رأسه، وفي اللحظة التي همّ بالقفز كي يشنق نفسه، يسمع صوت همسات وآهات ويلمح من فوق جسدين متداخلين وراء الأجمة، عرف أنهما لشاب وفتاة عاشقين تعرّف إليهما قبل رحلة البحر، وظنّ أنهما غرقا. هالة الجمال التي كانت تحيط هذين العاشقين، مع أصوات العصافير، وخيوط الشمس التي راحت تشرق مبشرة بصباح جديد، تشعل في داخله شهوة الحياة من جديد. بتخطيط نمطي مسبق، لم تقتل الكاتبة بطل روايتها، رغم فائض فداحة الموت في الواقع!!
ليس بالإمكان إلا الاعتراف بالخيال الخصب للكاتبة، وجمال اللعبة الفنية التي استخدمتها، لكن ما يؤخذ على الرواية هو فقدانها للصدق الفني الذي تجلّى في مفاصل عديدة.
المصدر: جيرون