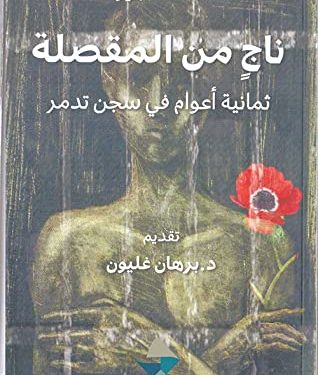عبده الأسدي
أن تكتب عن حكايات السجن فهذا يعني أن السجن لم يفارقك. تحاول أن تتمالك نفسك، وأن تحكي القصة وتسرد الرواية، وتسأل نفسك، فتجيب: ” كل سجين بذاته حكاية مستقلة، وإن تقاطعت المسارب في تلك الحكايات”.
في كتاب “ناجٍ من المقصلة” يطرق محمد برو جدار الصمت، الذي خيّم حول سجن تدمر الرهيب، أكثر السجون السورية وحشية وإجراما. يصرخ الكاتب، السجين الفتى سابقاً، والذي لم يكن قد تجاوزعامه السادس عشر حين دخل السجن، يصرخ عالياً، من أجل كل أمّ فقدت ولدها، و من أجل كل زوجة ترمّلت، و كل ابنة وإبن تيتّم، وكل أخت فقدت سندها.
من أجل هؤلاء كلهم، يصرخ برو الذي نجا من المقتلة أو من “المقصلة”، يصرخ من أجل إحقاق العدل والعدالة، فلا صفح دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة، ولا محاسبة دون إزالة نظام مستبد، مارس ومازال، أبشع أنواع وصنوف الاستبداد التي عرفتها البشرية.
نمضي مع محمد برو في سرده المرير، فندخل سجن تدمر، كما دخله من بوابته، في صيف سوري ملتهب من العام 1980، تمنحك اللوحة المكتوبة بخط أسود رديء “الداخل مفقود والخارج مولود” الإحساس بأن العالم من خلفك قد انتهى، وأن عالماً جديداً ينتظرك قد بدأ، لا يعرفه خفاياه إلا من خبره، وعاش مرارته.
ويمر برو كما مر المئات قبله “بحفلة التشريفة” وهي حفلة روتينية لاستقبال السجناء للمرة الأولى، ويحالفه الحظ بالنجاة من براثن الذئاب الجائعة والمتعطّشة للدماء.
وتمضي في قراءة الكتاب، ومن هول الأحداث، يتسلل إليك خوف من سطوة النظام، وأنت البعيد عنه آلاف الكيلومترات، تدرك أن ما فعله بثورة السوريين هو استمرار طبيعي لطبيعته التوحشية النابعة من عصبويتة الطائفية البغيضة. ويستحضرني هنا مؤلف كتاب “الدولة المتوحشة” لميشيل سوار، الذي لقي حتفه إعداماً عام 1986، وبقي رفاته محتجزاً لمدة عشرين عاماً، ولم تشفع له جنسيته الفرنسية ولا عيناه الزرقاوان من ملاقاة مصير مؤلم، لا لشيء إلا لأنه كتب ما يتوجب كتابته عن نظام دموي طائفي عصبوي.
يضعنا المؤلف صاحب التجربة، بأسلوبه العفوي داخل بيئة السجن، لا يعنيه تخليق أسلوب أدبي شيق، بل همّه أن يروي، وأن تصل روايته كل الأسماع، أن يكشف المستور، وما كان ويكون وراء القضبان وفي أم السجون السورية.
يقول كلمته واضحة بسيطة كالماء لكنها موجعة، ترتعش لها شغاف القلب، وتجعلك تتساءل في كل لحظة: أيعقل أن هؤلاء الوحوش بشراً مثلنا يعيشون في ظهرانينا؟ كيف لبشر أن يصل إلى هذا الحد من التوحش وانعدام الحس وأن يجد لذته في تعذيب آخرين بلا توقف؟ وكيف لجسد بشري أن يقدر على تحمّل هذا الكم من الألم؟ لولا خيط رفيع يمده بالصبر على أمل الخلاص، فيصمد الجسد المضنى أمام سوط الجلاد وتعتاد العين عتمة السجن، واللسان عفن الخبز اليومي.
وتستمررحلة العذاب اليومي، وهي صراع بين أشرار تافهين، يمارسون ساديتهم على أجساد سجناء لا حول لهم ولا قوة.
بيئة السجن لم تغادر صاحبنا محمد برو، لا بل إنه نجح في إدخالنا إلى عوالمه، لنشهد معه بعضاً من ألمه، ألم السجناء وصراخهم والقليل جداً من أحلامهم.
ينقل إلينا محمد برو حفلات التعذيب التي كانت تتم في سجن تدمر، وجلسات الإعدام التي يتم تصويرها لنقلها إلى حافظ الأسد، كمأثرة وإنجاز للسجن.
حينما تحدثنا حنه أردنت في كتابها عن ” تفاهة الشر” يبدو واضحاً أن الشر المستوطن في أعماق البشر يخرج كما الذئب متعطشا للدم، ويصبح فيما بعد عملاً روتيناً. وكذلك يحدثنا برو عن جلاديه: ” لقد فقدوا إنسانيتهم، وتأصل الشر والحقد في نفوسهم، واستذأبت أرواحهم، ولم يعد بمقدورهم التوقف عن التنكيل المستمر بنا، فقد أصبحت عملية التعذيب بحد ذاتها ولعاً لنفوسهم السقيمة.”
ما استوقفني في كتاب ” ناج من المقصلة” هو محاولة الكاتب أن يغوص عميقاً في أعماق النفس البشرية للسجان: ” كيف كان يتحول السجان الذي وفد حديثاً إلى سجن تدمر من كائن مصدوم من هول ما يراه…إلى مجرم متمادٍ في إجرامه متلذذ به؟ ” كيف يمكن تفسير سلوك السجانين، هل ولدتهم أمهاتهم مجرمين يتلذذون بتعذيب ضحاياهم، ويستمتعمون بسماع صراخهم يشق عنان السماء؟ كيف يمكن أن ينظر الواحد منهم في عيون أطفاله، وكيف له أن ينام مع زوجته؟ وأن يأكل ويشرب، أو يحتسي الشاي مع قطعة حلوى؟ من أي طينة خلقوا هؤلاء؟
ربما نستطيع أن نتفهم سلوك مدير السجن المجرم فيصل غانم، المتماشي مع أيديولوجيته أو عصبويته الطائفية، لكن كيف يمكن أن نفسر سلوك الضباط الصغار، الذين يتباهون بالتفنن في طرق التعذيب، كحال السجان “هوشابا”الذي كان ينتشي ويتلذذ بسماع صراخ الضحية تحت وطأة كرباجه.
أما فيصل غانم، فلربما يذكرنا بشخصية سهيل الحسن (النمر) بكل تفاهتها وسطوتها، عندما قال مخاطبا أحد السجناء بعد “أن تجرأ” وقال إنه لا يوجد أي اتهام ضده: “إذا كنت بريئاً، تأكد أنك لن تظلم قيد شعره، ستخرج ولو بعد مئة عام”.
صحيح أن محمد برو يضعنا في صورة التفاصيل المهولة حد الموت، لكنه أيضا يحدثنا عن أمل ظل حاضراً في نفوس السجناء، بأنهم يوما ما سيكونون أحراراً حتى لو طال الزمن.
يحدثنا عن ابتكار مدهش اكتشفه السجناء، باستخدامهم ألواح الصابون لكتابة بضعة أبيات من الشعر، وكأنهم يقارعون سجانيهم بوعيهم وأحلامهم وعدم انكسارهم، أو انكسار إرادتهم.
ليس لي من بد إلا التأكيد على أن الكتاب هو وثيقة تاريخية بالغة الأهمية، عن تجارب أناس خبروا واحدا من السجون التي تحتل الريادة في القسوة والوحشية والتعذيب، ويشهد له في حفلات الإعدام الجماعي، وتضاف المجزرة التي ارتكبها المجرم رفعت الأسد إلى سجلات هذا السجن؟
ما فعله النظام السوري بحق السوريين المطالبين بالحرية والكرامة، يندرج في سياق ممارسات هذا النظام، وليس طارئاً، بل له علاقة عضوية وبنيوية في تركيبة هذا النظام، وفي آليات تثبيت حكمه، وفي تدعيم سطوة سيطرته، وفي فرض هيبته، وفي سحق خصومه، وفي تدمير النسيج المجتمعي السوري.
إنه نظام أبرع من هتلر في القتل، وأشنع من ستالين في التعذيب، وأحط من بن غوريون في الكذب والتلفيق والتطهير العرقي، إنه نظام يجمع في جنباته العصبوية الطائفية، ويستخدم أيديولوجية قومية كغطاء لعصبويته، ويمارس قهراً ما بعد قهر ضد السوريين منذ خمسين عاماً، وما زال.
ما أقدم عليه النظام في سجن تدمر، هو اختصار مكثف لما فعله في كل سورية والسوريين، ولو لم يوثق محمد برو والآخرون ممن خبروا المقتلة شهاداتهم، فمن كان سيخبرنا بقصص ما وراء القضبان بتفاصيلها المرعبة؟ من كان سوف يخبرنا بسردية السجناء والمقهورين حتى تمني الموت. ألم يقل يومًا جان بول سارتر أنه : ” يجب أن نتقبل انعدام المعنى بشجاعة وإقدام” وأن هذا المذهب هو الذي يفضي إلى شيوع حالات اليأس والانتحار، لكنه لم يفض حتى إلى محاولة انتحار واحدة في السجن الرهيب تدمر؟ أليس ذلك أمراً يستحق التوقف عنده؟