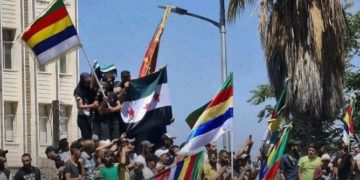لميس أندوني
“فلسطين حرّة تعني دولة شبيهة “بحكم طالبان” تحكمها حركة حماس الفاشية.” (سلمان رشدي/ 20/5/2024)
ليس جديداً توظيف الرّهاب من المسلمين والتمييز ضدهم، في تبرير الاستعمار الغربي، فتقويض إنسانية “الآخر” وشيطنته من أهم أدوات إحكام السيطرة على الشعوب والتنكيل بها. لذا نرى حالياً هجمة إسلاموفوبية شرسة دفاعا عن إسرائيل مع معاداة الشعب الفلسطيني. فمن الكاتب البريطاني العنصري دوغلاس موراي إلى الروائي البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي، ينخرط مثقفون في توظيف الإسلاموفوبيا لتبرير حرب الإبادة الإسرائيلية ورفض حرّية الفلسطينيين وتحرّرهم، أحياناً بحجّة التوجّه الأيديولوجي لحركة حماس، لكنها في معظمها انطلاقا من الدفاع عن إسرائيل والسياسات الأميركية.
لا توجد قواسم مشتركة بين موراي ورشدي، فالأول يميني معروف بكراهيته الإسلام واحتقاره المسلمين، والآخر مسلم ويعي تماما عدالة القضية الفلسطينية، لكنه اختار منذ أكثر من عقدين استرضاء الغرب وترويج السياسات الأميركية ابتداءً من حرب العراق وصولاً إلى إعلانه العداء لإقامة دولة فلسطينية، في تماهٍ تامٍّ مع قادة إسرائيل والصهاينة في واشنطن.
في حالة موراي، الذي تتسابق محطات التلفزة لمقابلته، ومراكز أبحاث أميركية وأوروبية لاستضافته، وبخاصة بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، هو عنصري يجاهر دائما بتحريضه ضد المسلمين في بريطانيا، ويرى، كما شرح في كتابه “الدفاع عن الغرب”، أنّ المسلمين خطر على المجتمعات وعلى الحضارة الغربية، فهو يستهجن وجود مسلمين “يشوّهون” أحياء المدن البريطانية “ويلوّثونها” لمجرّد أنهم مسلمون.
عليه؛ يعتبر أن إسرائيل خط الدفاع الأول عن الحضارة الغربية، تماما كما كان يبشّر به زئيف جابوتنسكي، أحد أهم مؤسسي قادة الحركة الصهيونية، ومنسجما مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول يوم للحرب على غزة، بأن هذه الحرب صراع بين الخير والشر، وبين الحضارة والمتوحشين. وعليه، طلع علينا موراي من المنظور نفسه مبرّرا لإسرائيل ما ترتكبه من احتلال وقتل واقتلاع للشعب الفلسطيني بوصفه ضروريا لحماية الحضارة الغربية، ليس لأن حركة حماس إسلامية، بل لأن ممثلة “الحضارة” إسرائيل تقوم بدورها في هزيمة “المتوحّشين”.
لذا أصبح مواري من أهم ممثلي الدفاع عن إسرائيل، تستعيض به وسائل الإعلام الغربية عن مسؤولين أو كتّاب إسرائيليين، فلديه ما يطلق عليه “لهجة أكسفورد” والملامح الأوروبية، أي أنه يجسّد التفوق العنصري “للرجل الأبيض”، ارستقراطي المظهر، للدفاع عن جرائم حرب باسم أخلاق “الغرب الحضارية” وأخلاقياته المشتركة مع إسرائيل.
أما رشدي فهو قصة أخرى، لا ينطلق من الإسلاموفوبيا، بل من قرار اتخذه في خدمة الحكومات الغربية، وبالأخص الأميركية، ورغبة بالانتماء إلى “الحضارة الغربية”، حتى لو أصبح بوقاً للسياسات الاستعمارية، فقد بدأ مسيرته مناصراً بليغاً للقضية الفلسطينية، وانقلب عليها في بدايات الألفية الثالثة، وكان المبرّر الذي يصر مناصروه عليه هو الفتوى الإيرانية بإهدار دمه بعد صدور روايته “آيات شيطانية” في 1988. لكنه مبرّر مرفوض، إذ كان رشدي من المدافعين عن القضية الفلسطينية عن قناعة، كما ارتبط بصداقة قوية مع المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد والمثقف اليساري الأميركي من أصول باكستانية إقبال احمد، إضافة إلى أن سعيد وأحمد وكتّاباً عرباً ومسلمين أعلنوا تضامنهم مع رشدي بصوت عالٍ قولاً وكتابة، ودافعوا عن حقه بالتعبير والحياة في وجه الفتوى الإيرانية.
بدأ الإعجاب برشدي قبل إصداره الرواية المثيرة للجدل “آيات شيطانية”، فروايته الأولى “العار”، كانت نقداً عميقاً للنخبة الباكستانية، ومثّلت الثانية “أطفال منتصف الليل” تشريحاً سياسياً واجتماعياً لتاريخ الهند. لكن انقلاب رشدي الفكري والسياسي إلى حد تقمّص شخصية الاستشراقي الاستعماري وضعه في خانة معاديةٍ تماماً، وإن كان ذلك ليس حجّة للفتوى الإيرانية، ولا لمحاولة قتله التي أفقدته البصر، فهذه جريمة اعتداء بشعة ومدانة، فهو ليس كالسياسيين الشعوبيين اليمينيين، ولا يشبههم، لكنه عمليا يكمل دورهم، ويعطيهم، لكونه مسلماً، مصداقية يفتقدونها هم وقادة إسرائيل.
المهم أن رشدي يردّد ما يبثه الصهاينة والسياسيون اليمينيون، وبعض الليبراليين الذين يغطّون عداءهم للفلسطينيين تحت شعار خطر الإسلام السياسي وتنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة، وهم يعرفون حقيقة كذبتهم، فحقّ تحرّر الشعوب غير مشروط بشكل الحكم. والصحيح أننا نأمل بفلسطين ديمقراطية، لكن هذه المقولات تعني قبول القتل اليومي وهدم المنازل والاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي وتشريد الفلسطينيين، ودعماً وقحاً لمشروع استيطاني إحلالي عنصري لفلسطين، وتوقيت مثل هذه المقولات التي يتبناها بعض الليبراليين هو تواطؤ، بل ومشاركة في حرب الإبادة ومحاولة محو هوية الشعب الفلسطيني.
يدافع هؤلاء أنفسهم ويدعمون الابارتهايد الكولونيالي في فلسطين، وحتى إنهم يبرّرون قتل الأطفال، كما فعل أستاذ العلوم السياسية جرايمي وود في مقال في مجلة أتلانتيك الأميركية، في 17 الشهر الماضي (مايو/ أيار)، بادّعائه أن قتل الأطفال يكون “قانونيا”، متّهما المنظمات الدولية بتقديم بيانات غير صحيحة عن عدد الأطفال الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزّة، منطلقاً من التصريحات الإسلاموفوبية نفسها، ليستغل تخويف الإنسان الغربي من الإسلام والمسلمين لتقويض إنسانية الفلسطيني وضحايا الحروب الأميركية.
المشكلة أن بعض العلمانيين العرب، وأعتبر نفسي علمانية، يتبنون بعض هذه المقولات التي تحذر من دولة فلسطينية إسلامية أو من انتصار حركة حماس في المواجهة. يختلف هؤلاء في رؤاهم، فبعضهم يعادي الشعب الفلسطيني بحجج مختلفة، ويتمنّى بعضهم الآخر خسارة “حماس” في المواجهة مع إسرائيل، ليس من قبيل عدم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنما من قبيل الخوف من استقواء التيار الإسلامي في العالم العربي بانتصار المقاومة الفلسطينية.
حسم من يعادون القضية الفلسطينية من “المثقفين العرب” موقفهم مع إسرائيل. أما الخشية من انتصار الإسلام السياسي في حال انتصار “حماس” فهو موقف قصير النظر، إذ إن انتصار إسرائيل كارثة على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.. أي أنّ هناك خشية من استشراء الإسلاموفوبيا، بمعنى الرّهاب من التيار الإسلامي، بين الأحزاب والمثقفين، تؤدي إلى نتيجة الإسلاموفبيا العنصرية الغربية نفسها، وإن اختلفت الدوافع.
أدعو المثقفين العرب إلى اتخاذ موقف حازم حيال الإسلاموفوبيا واستغلالها لتمرير حرب الإبادة الإسرائيلية، فهناك فرقٌ بين معارضة التيار الإسلامي أيديولوجياً والتقصير في مواجهة أدوات الاستعمار والصهيونية.
المصدر: العربي الجديد