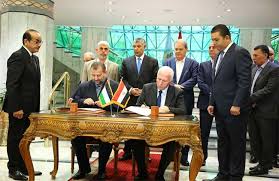ثلاثون عاما مضت على إعلان ياسر عرفات وثيقة إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في قصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية بتاريخ 15/11/1988، من دون أي إنجاز يذكر على صعيد تنفيذ الوثيقة، بل على العكس تماما، بات الوضع الفلسطيني الداخلي غارقا في انقسامات وصراعات عديدة ومتعددة، بعضها يعكس مطامح سلطوية ضيقة، والآخر ناجم عن الغضب والاحتقان الشعبي المتزايد يوماً بعد يوم، على مدى الانحدار والضعف الذي بلغناه. في المقابل انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة في العام 2005 تحت ضغط المقاومة، وتمكن المجلس الوطني الفلسطيني من الانعقاد داخل فلسطين هذا العام ولأول مرة منذ تشكيله، وهو ما أوحى للبعض بدنو تحقيق الدولة المستقلة، وإن ثارت الخلافات حول الأسلوب الحقيقي الأنجع والأسرع بين مؤيدي حماس وفتح. إذ نجد اليوم هوة كبيرة بين من يعتقد أن نقل اجتماعات لجان وهيئات منظمة التحرير إلى داخل فلسطين، وخصوصا رام الله، مؤشرا على قرب تحقيق الحلم الفلسطيني، وبين من يرى غزة نموذجا مصغرا للدولة الفلسطينية المستقلة، وبين رؤى مخالفة لكل ما سبق، تعتقد أن حلم الدولة يبتعد يوما بعد يوم في ظل مخاطر المخططات الدولية المنسجمة كليا مع مخططات الاحتلال، ونتائج الوضع الداخلي الفلسطيني المرتهن كلياً للخارج أو للاحتلال أو لكليهما، في كل من الضفة وغزة على حد سواء. إذ يصعب اليوم التقريب بين أي من وجهات النظر سابقة الذكر، على الرغم من انطلاقها جميعا من الهدف ذاته: الدولة؛ ما يقودنا لاستنتاج أن جذر المشكلة ينطلق من الاختلاف في معنى الدولة الفلسطينية المستقلة. فمن البديهي ملاحظة أن جميع القوى والأطراف الداخلية والخارجية ترفع شعار الدولة الفلسطينية المستقلة، كهدف لا بديل عنه من أجل حل المأساة الفلسطينية. لكن يختلف مفهوم الدولة من طرح إلى آخر، حتى يكاد يتحول هذا الشعار في بعض الحالات إلى نقيضه تماما. فعادة ما تتمتع الدولة المستقلة بحدود جغرافية متعارف عليها ومحددة بدقة عالية، باستثناء بعض الحالات الناجمة عن خلافات حدودية محدودة ومحددة حول بعض الدونمات ذات الخصوصية الجغرافية أو التاريخية التي يصعب حلها. كما تعمل الدولة على بسط سيادتها الكاملة وغير المنقوصة على أمنها وحدودها ومواردها واقتصادها، وهي مسؤولة كذلك عن حماية مواطنيها، وصيانة العقد الاجتماعي القائم، وتطويره، كي يتمكن من تجاوز الخلافات الاجتماعية والسياسية، وبما يصون حقوق جميع مواطنيها الفردية والجماعية. كما تختلف الدول في نظامها الداخلي وفق النهج الذي تتبعه بين دولة استبدادية وقمعية، تكم الأفواه وتعتقل الأصوات المعارضة والخارجة عما يرتئيه النظام القائم، كما يحدث في محيطنا العربي، أو تكون دولة ديمقراطية تصون حرية الرأي والاعتقاد ضمن إطار قانوني يجعل من الخلاف في وجهات النظر عاملا من عوامل حماية الوحدة المجتمعية، وحماية الدولة ذاتها. للأسف يسهل تلمس الممارسات والنهج الاستبدادي في كل من غزة والضفة، على الرغم من صعوبة العثور على أي أثر يذكر من مقومات الدولة. فالسيادة الجغرافية والاقتصادية والوطنية مستباحة ومنتهكة يوميا، عبر عمليات القنص التي تطاول المواطنين، والممارسات التي تحد من حرية حركتهم داخل هذه الأراضي، وفي مجالها الحيوي المائي والبري، كما يتم حجز الأموال والتحكم في حركة السلع منها وإليها، والعديد من المظاهر الأخرى، التي يمكن اختزالها بعبارة بسيطة وواضحة: الأراضي الخاضعة للاحتلال؛ وهو ما ينفي إمكانية وجود أو بناء أي دولة مستقلة وعلى أي شبر من أرض فلسطين، دون إنجاز عملية التحرير الحقيقية والكاملة، بعيداً عن أوهام التحرر النسبي الذي حول الضفة وغزة إلى سجون يديرها الاحتلال عن بعد. لكن وعلى الرغم من غياب مقومات الدولة عن كل من الضفة وغزة، إلا أن النهج الاستبدادي حاضر وبقوة، من أجل حجب هذا القصور، تماما كما يعمل الانقسام الفئوي على تضليل الشعب عن حقيقة الصراع المصلحي بين شطري الصراع. لذا لا يمانع الاحتلال بناء “دولة” مشوهة تابعة وخاضعة كليا له، أو معزولة ومحاصرة وعاجزة عن الاستمرار دونه، فبكلا الحالتين سوف تستمد هذه “الدولة” شرعيتها القانونية والسياسية والأمنية منه فقط، ما يجعلها بحكم الواقع “دولة” استبدادية فئوية، تنطلق من حماية مصالح الاحتلال والمجموعات أو الفئات التي تمثلها، على حساب جميع القيم والمقومات والعوامل الوطنية والإنسانية والشعبية الأخرى. وهو للأسف ما يتطابق بشكل كبير مع الوضع القائم في كل من الضفة وغزة، المليء بحالات القمع والاعتقال بحق أي شخص يخالف رأيه رأي السلطة المسيطرة حول أي قضية كانت، دينية، قانونية، سياسية، أم اجتماعية، وهناك العديد من الأمثلة على عمليات الاعتقال المتبادلة بحق كوادر الحركتين في أماكن سيطرة الحركة الأخرى، وكذلك بحق جزء كبير من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين، الذين يعارضون ولو جزئيا توجهات كلا الحركتين في أماكن سيطرتهما، فلا صوت يعلو على صوت حماس في غزة، تماما كما لا صوت يعلو على صوت فتح أبو مازن في الضفة. إذ تتم صياغة الإجماع الوطني في كل منهما بما يمثل هذه الحقيقة ويجسدها؛ سواء عبر اجتماعات منظمة التحرير، أو عبر اجتماعات الفصائل في غزة والقاهرة، فهي اجتماعات لأي مكون سياسي أو شعبي يرضخ ويقر ويعترف بهذه “الدولة” الفصائلية. وهو ما يبرر عجز الحركتين عن انتهاج المسار الديمقراطي، وعن تأمين مستلزمات الفلسطينيين القاطنين في مناطقهما، سواء المعيشية أم الأمنية، وعليه فقد فشلت حماس في بناء الدولة عبر رؤيتها وإدارتها لمقاومة فئوية ذات مآرب تعبوية، تماما كما عجزت فتح في ذلك عبر مسار التفاوض والاستسلام الطويل. وبالتالي، وكي نستعيد شعار ومسار النضال والعمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والواحدة، لا بد من تجاوز تبعات وآثار “الدولة” الفصائلية، عبر تجاوز الفئات والمجموعات التي زرعتها ورعتها وعززتها، لأنهما نقيضان لا يمكن الجمع بينهما. فمهما طال عمر القيادة